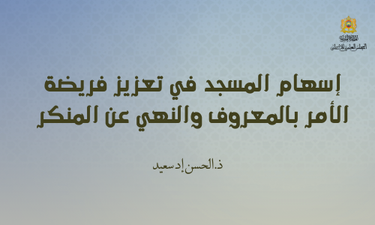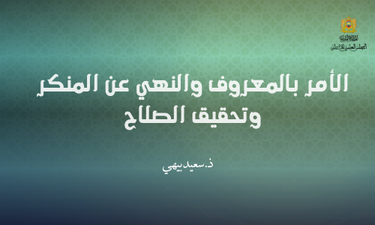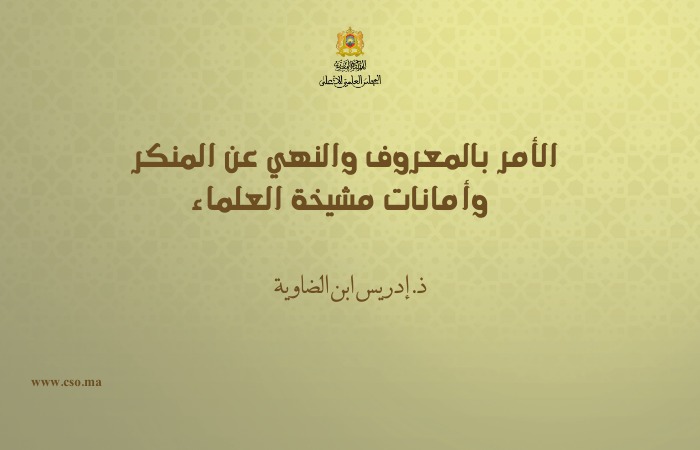تبليغ الدين في الثقافة الرسالية: المفاهيم والمقتضيات والأبعاد؛ مقالة بمجلة دعوة الحق، كتبها الأستاذمحمد بنكيران (رئيس المجلس العلمي المحلي للفحص أنجرة) ضمن مقالات العدد 450 بتاريخ ذو القعدة 1446/ أبريل 2025؛
تبليغ الدين في الثقافة الرسالية..المفاهيم والمقتضيات والأبعاد
ذ.محمد بنكيران
من المقرر المعلوم أن الإنسان يمثل -على مستوى المخلوقات- محور هذا الكون بلا شك، لأنه المؤتمن على ثرواته، وصاحب التأثير القوي النافذ فيه، إيجابا وسلبا، وكان دائما هو المخاطب بالرسالات السماوية، وما من دراسة في الآفاق أو الأنفس إلا وهو المقصود الأول والأخير بها، لأن أثرها راجع إليه، ومعقد الفائدة دائر عليه.
لكن المثير في هذا الإنسان هو أن في بنيته الداخلية وتركيبته النفسية قابلية خطيرة للشر والعدوان، كقابليته للخير والإحسان، وهذه القابلية تحتاج دوما إلى رعاية وترشيد، وإلا انقلبت القابلية التي بداخله للشر إلى طوفان مدمر للحياة والأحياء، كل على قدر ما لديه من إمكانيات وقدرات، وما هو إلا كما قال المتنبي:
والظُّلمُ من شِيَم النُّفوسِ فَإِن تَجِدْ … ذَا عِفَّةٍ فلعِلَّة لَا يَظْلِم
ومن السهل تخيل ما يمكن أن ينتج عن ذلك من المضار والدمار، طالما أن واقع الإنسان وتاريخه يدلان بكل وضوح على ذلك.
لأجل ذلك كان البحث في الإنسان من الجانب الأخلاقي عريقا بتساؤلاته وإشكالاته وقضاياه..
وهذا البحث اقترن به التفكير في صورة المجتمع الآمن أو المدينة الفاضلة التي يعيش فيها الناس بسلام ووئام، وكرامة واحترام.
وهذا يعني ضرورة وجود أناس رساليين في كل مجتمع، يحملون على عاتقهم هم الرعاية ورسالة الإصلاح، بكيفية دائمة، وبكامل المسؤولية، وعلى نحو تكون لهم فيه الكلمة العليا والتأثير الفعال.
وهؤلاء الرساليون يفترض فيهم بداهة أن يكونوا في أنفسهم على مستوى رفيع من الصفاء والطهر، والكفاءة الأخلاقية التي تؤهلهم لإصلاح غيرهم.
وفي المنظومة الدينية لم يتحقق هذا على التمام والكمال إلا للأنبياء والرسل، الذين اختارهم الله على علمه، وصنعهم على عينه، وأدبهم بآدابه، وجعلهم أنموذجا يحتذى في الطهر والتطهير، وفي الكمال والتكميل: ﴿أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُدَىٰهُمُ اٱقتَدِه﴾ الأنعام: 90
ومن ثم كانوا للرسالية مرجعا، تعرف بهم مفاهيمها وشروطها ومقوماتها وأهدافها وأبعادها وكل متعلقاتها، وهو ما يعني أن الرسالية صارت بوجودهم ثقافة متكاملة الأركان، تتيح لمن أراد أن يحذو حذوهم القدرة على نهج خطاهم بكامل الفهم والوعي والاقتدار.
وليس يعني هذا أن هؤلاء الرسل تمت لهم الاستجابة بشكل كلي، ولا أنها استدامت لهم، وإنما الواقع هو أنهم كما قوبلوا بالطاعة والاتباع من فئات، ووجهوا في الوقت ذاته بالتعنت والتمرد والرفض من فئات أخرى، ثم بالإخلال والتقصير من فئات أصابها مع الزمن الوهن رغم إيمانها واستجابتها.
وهذه الفئة التي قد تمثل جزءا لا يستهان به داخل مجتمع المستجيبين والمؤمنين تحتاج إلى رعاية وتقويم، لردم الهوة بين تدينها والدين الذي تؤمن به من لدن هؤلاء الإصلاحيين المتمثلين للثقافة الرسالية، الذين يحملون مشعل الأمل في الأمة، وراية الهداية والنور في ظلم الانحراف والجور.
بيد أن الأساس في هذه الرسالية يتمحور حول مبدإ مركزي هو «التبليغ» الذي لا يمكن تصور القيام بوظائف الرسالية المتمثلة أساسا في الإصلاح الشمولي إلا انطلاقا منه، باعتباره الوسيلة المثلى للتواصل والتحاور والإقناع، والوصول إلى قلب المتلقي الذي هو مرتكز حركته، وموجه تصرفاته وفعاله: «ألا وإن في الجسد مضغة: إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب»(1).
فماذا يعني التبليغ في المنظومة الدينية؟ وما هي حقيقته؟ والمفاهيم التي تنضوي تحته؟ وكذا الشروط التي يتطلبها؟ والأبعاد التي ينطوي عليها في ظلال الثقافة الرسالية؟
كل ذلك هو ما سنحاول الجواب عنه في هذا المقال.
التبليغ: المفهوم والأبعاد
يمثل واجب التبيلغ في سيرة الرسل والأنبياء الوظيفة المحورية والمهمة الأساس التي بعثوا بها ولأجلها في الناس، حتى كان هذا المبدأ أشرف أوصافهم، وأجمل نعوتهم عند خالقهم ومرسلهم، الذي اختار في ثنائه عليهم توصيفهم بذلك فقال: ﴿اِ۬لذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَٰلَٰتِ اِ۬للَّهِ وَيَخْشَوْنَهُۥ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَداً اِلَّا اَ۬للَّهَۖ وَكَف۪يٰ بِاللَّهِ حَسِيباٗۖ﴾ الأحزاب: 39.
وهذا فقط حينما ننظر إليهم من جانب الرسالة والتكليف الذي كلفوا به تجاه أممهم وأقوامهم، وإلا فأوصافهم من النواحي الأخرى كلها سَنِية كريمة، مضيئة رفيعة، فهم مذكورون على الدوام بجميل الثناء، وعظيم الإطراء، ويكفينا من ذلك التذكير بقوله تعالى عنهم: ﴿وَكُلّاٗ جَعَلْنَا صَٰلِحِينَۖ ۞وَجَعَلْنَٰهُمُۥٓ أَئِمَّةٗ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَاۖ وَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِمْ فِعْلَ اَ۬لْخَيْرَٰتِ وَإِقَامَ اَ۬لصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءَ اَ۬لزَّكَوٰةِ وَكَانُواْ لَنَا عَٰبِدِينَۖ﴾ الأنبياء: 73.
وقوله عز من قائل: ﴿إِنَّهُم كَانُواْ يُسَٰرِعُونَ فِي اٱلخَيرَٰتِ وَيَدعُونَنَا رَغَبٗا وَرَهَبٗا وَكَانُواْ لَنَا خَٰشِعِينَ﴾ الأنبياء: 90.
والذي يظهر من آي الكتاب الحكيم أن واجب التبليغ في حق الرسل لا يتقدم عليه شيء مطلقا، بدليل قوله تعـالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا اَ۬لرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَۖ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَٰتِهِۦۖ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ اَ۬لنَّاسِۖ إِنَّ اَ۬للَّهَ لَا يَهْدِے اِ۬لْقَوْمَ اَ۬لْكٰ۪فِرِينَۖ﴾ المائدة: 67.
ولهذا كان الرسل في جوابهم عن تكذيب أقوامهم يحيلون دائما على قيامهم بواجب التبليغ في حقهم، على أساس أن ذلك هو ما يسقط التبعات عنهم، ويقيم الحجة على أولئك الأقوام في تكذيبهم وصدودهم.
جاء ذلك على لسان نوح عليه السلام إذ ﴿ قَالَ يَٰقَوْمِ لَيْسَ بِے ضَلَٰلَةٞ وَلَٰكِنِّے رَسُولٞ مِّن رَّبِّ اِ۬لْعَٰلَمِينَۖ أُبَلِّغُكُمْ رِسَٰلَٰتِ رَبِّے وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اَ۬للَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَۖ﴾ الأعراف: 61-62.
وعلى لسان هود عليه السلام إذ ﴿قَالَ إِنَّمَا اَ۬لْعِلْمُ عِندَ اَ۬للَّهِ وَأُبَلِّغُكُم مَّآ أُرْسِلْتُ بِهِۦ وَلَٰكِنِّيَ أَر۪يٰكُمْ قَوْماٗ تَجْهَلُونَۖ﴾ الأحقاف: 23.
وعلى لسان صالح عليه السلام: ﴿فَتَوَلّ۪يٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَٰقَوْمِ لَقَدَ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّے وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ اَ۬لنَّٰصِحِينَۖ ﴾ الأعراف: 79.
وعلى لسان شعيب عليه السلام: ﴿فَتَوَلّ۪يٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَٰقَوْمِ لَقَدَ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَٰلَٰتِ رَبِّے وَنَصَحْتُ لَكُمْۖ فَكَيْفَ ءَاس۪يٰ عَلَيٰ قَوْمٖ كٰ۪فِرِينَۖ﴾ الأعراف: 93.
ومما يزيد هذا تأكيدا -إن كان الأمر يحتاج إلى تأكيد- قوله تعالى: ﴿قُلِ اِنِّے لَنْ يُّجِيرَنِے مِنَ اَ۬للَّهِ أَحَدٞ وَلَنَ اَجِدَ مِن دُونِهِۦ مُلْتَحَداً اِلَّا بَلَٰغاٗ مِّنَ اَ۬للَّهِ وَرِسَٰلَٰتِهِۦۖ﴾ الجن: 22-23.
ومعناه كما جاء في تفسير ابن كثير: «لا يجيرني منه ويخلصني إلا إبلاغي الرسالة التي أوجب أداءها علي».
ونظير هذا قوله تعالى: ﴿عَٰلِمُ اُ۬لْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَيٰ غَيْبِهِۦٓ أَحَداً اِلَّا مَنِ اِ۪رْتَض۪يٰ مِن رَّسُولٖ فَإِنَّهُۥ يَسْلُكُ مِنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِۦ رَصَداٗ لِّيَعْلَمَ أَن قَدَ اَبْلَغُواْ رِسَٰلَٰتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْص۪يٰ كُلَّ شَےْءٍ عَدَداٗۖ ﴾ الجن: 26-28.
وتأكيد هذا المعنى باعتباره المهمة الأصل للرسول ورد في القرآن الكريم معادا في مواضع كثيرة، نذكر منها قوله تعالى: ﴿مَّا عَلَي اَ۬لرَّسُولِ إِلَّا اَ۬لْبَلَٰغُۖ﴾ المائدة: 99، وهي الآية التي جاء على منوالها ما يفوق العشر الآيات.
ومع كل هذا لا ينبغي أن نغفل عما سطره القرآن من الاختصاصات الكثيرة للرسول، التي منها: البيان، والنصح، والتزكية، والتقويم، والإصلاح، والحُكم، والتذكير، والعظة .. وغير ذلك مما يبني الإنسان على الفضائل والمكرمات، بعد تخليصه من شرور نفسه وعللها، التي تنتهي به إذا أهملت واستفحلت إلى ما يسميه القرآن بالفساد، المحدث لكل الأزمات والمشكلات، والمانع من تحقيق الحياة الطيبة الموعود بها في الدنيا، والمعيق في ذات الوقت عن الوصول إلى حضرة الله ونيل رضاه.
ويمكن أن نذكر من الأدلة القرآنية على تلكم الاختصاصات ما جاء في قوله تعالى: ﴿لَقَدْ مَنَّ اَ۬للَّهُ عَلَي اَ۬لْمُومِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاٗ مِّنَ اَنفُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمُۥٓ ءَايَٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ اُ۬لْكِتَٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِے ضَلَٰلٖ مُّبِينٍۖ ﴾ آل عمران: 164.
وقوله سبحانه: ﴿وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ اَ۬لذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَۖ﴾ النحل: 44.
وقوله عز من قائل: ﴿ كِتَٰبٌ اَنزَلْنَٰهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ اَ۬لنَّاسَ مِنَ اَ۬لظُّلُمَٰتِ إِلَي اَ۬لنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمُۥٓ إِلَيٰ صِرَٰطِ اِ۬لْعَزِيزِ اِ۬لْحَمِيدِ﴾ إبراهيم: 1.
وقوله: ﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ اَ۬لذِّكْر۪يٰ تَنفَعُ اُ۬لْمُومِنِينَۖ﴾ الذاريات: 55.
وقوله: ﴿كِتَٰبٌ اُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِے صَدْرِكَ حَرَجٞ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِۦ وَذِكْر۪يٰ لِلْمُومِنِينَۖ﴾ الأعراف:2.
وقوله عز من قائل: ﴿وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِےٓ أَنفُسِهِمْ قَوْلاَۢ بَلِيغاٗۖ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اِ۬للَّهِۖ وَلَوَ اَنَّهُمُۥٓ إِذ ظَّلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمْ جَآءُوكَ فَاسْتَغْفَرُواْ اُ۬للَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ اُ۬لرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اُ۬للَّهَ تَوَّاباٗ رَّحِيماٗۖ ۞فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُومِنُونَ حَتَّيٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِےٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجاٗ مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماٗۖ﴾ النساء: 63-65.
وقوله: ﴿اِنَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ اَ۬لْكِتَٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ اَ۬لنَّاسِ بِمَآ أَر۪يٰكَ اَ۬للَّهُۖ وَلَا تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيماٗۖ﴾ النساء:105.
وهي آيات تحتاج إلى وقفات تدبرية لمعرفة مقام الرسالة، وتشخيص الوظائف الكثيرة للرسول في الأمة.
ومما يزيد هذا بيانا وتوضيحا أن كل واحد من الرسل تفرغ -بحسب العرض القرآني- لعلاج ظواهر الانحراف الواقع في قومه.
فكان لشعيب عليه السلام تبليغ ودعوة تركز على انحرافاتهم في المعاملات التجارية بينها القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿وَإِلَيٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْباٗۖ قَالَ يَٰقَوْمِ اِ۟عْبُدُواْ اُ۬للَّهَ مَا لَكُم مِّنِ اِلَٰهٍ غَيْرُهُۥۖ وَلَا تَنقُصُواْ اُ۬لْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَۖ إِنِّيَ أَر۪يٰكُم بِخَيْرٖ وَإِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٖ مُّحِيطٖۖ وَيَٰقَوْمِ أَوْفُواْ اُ۬لْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِۖ وَلَا تَبْخَسُواْ اُ۬لنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْاْ فِے اِ۬لَارْضِ مُفْسِدِينَۖ﴾ هود: 84-85.
وكانت مهمة لوط عليه السلام مختصة بعلاج آفة أخرى ورد بيانها في قوله سبحانه: ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ اِ۬لْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمُۥٓ أَخُوهُمْ لُوطٌ اَلَا تَتَّقُونَ إِنِّے لَكُمْ رَسُولٌ اَمِينٞۖ فَاتَّقُواْ اُ۬للَّهَ وَأَطِيعُونِۖ وَمَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنَ اَجْرٍۖ اِنَ اَجْرِيَ إِلَّا عَلَيٰ رَبِّ اِ۬لْعَٰلَمِينَۖ أَتَاتُونَ اَ۬لذُّكْرَانَ مِنَ اَ۬لْعَٰلَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنَ اَزْوَٰجِكُمۖ بَلَ اَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَۖ﴾ الشعراء: 160-166.
وهكذا الحال في بقية الرسل بلا استثناء، بما يدل على أن الأمر يتعلق بوظائف كثيرة كانت لهم، هي على نحو لا يصح أن يقال عنها إنها تتجاوز التبليغ أو تناقضه، وإنما هي في الحقيقة من موجباته ومقتضياته وبالتالي فهي فرع عنه ومظهر له.
ومن الخطإ الشنيع أن يُستصغر شأن الرسالة والرسول من خلال استدلال سطحي سقيم بآيات التبيلغ، انتزاعا من السياق والسباق والنسق العام للقرآن والسنة، كما يجري ذلك على لسان البعض وفي كتاباتهم.
هذا وإن كل ما سبق يقودنا إلى القول بأن التبليغ مفهوم كبير، ومصطلح أصيل، يمتاز ككثير من المفاهيم والمصطلحات الشرعية بالتركيز والكثافة، وأن حمولته الدلالية متسعة اتساعا كبيرا، إلى حد أنه يكاد يتلاشى الفرق بينه وبين ما ينضوي تحته من المستلزمات والفروع والمقتضيات، بمعنى أن بإمكاننا أن نعتبر أن التبليغ هو البيان، وأنه العظة، وأنه التزكية، إلى آخر ما سبق من الوظائف الرسالية.
والرسالية مبدأ يسري على حملة الرسالة عامة وعلى طائفة العلماء خاصة، بما اؤتمنوا عليه من التبيلغ المسدَّد للدين، وذلك حسبما يفهم من قوله تعالى: ﴿وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا اَ۬لْقُرْءَانُ لِأُنذِرَكُم بِهِۦ وَمَنۢ بَلَغَۖ﴾ الأنعام: 19، قال محمد بن كعب، في قوله {وَمَنْ بَلَغَ}: «من بلغه القرآن، فكأنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه» (2). وقال قتادة، في قوله تعالى: {لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ}: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «بلغوا عن الله» فمن بلغته آية من كتاب الله، فقد بلغه أمر الله»(3).
وليس في الناس من هو أحق بهذا الأمر من العلماء الذين قال الله تعالى عنهم: ﴿شَهِدَ اٱللَّهُ أَنَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَٱلمَلَٰٓئِكَةُ وَأُوْلُواْ ٱلعِلمِ قَآئِمَۢا بِاٱلقِسطِۚ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلعَزِيزُ ٱلحَكِيمُ﴾ آل عمران: 18، وهي خصوصية عظيمة لهم في هذا المقام تستوجب أن تصان بما يلائمها من الشروط الضامنة لسداد التبليغ ونجاحه لتحقيق أهداف وآماله.
مقتضيات التبليغ وشروطه
نعرض تحت هذا العنوان المهمَّ من هذه الشروط على سبيل الإجمال والتركيز، فنقول:
أولا: إن أولى الشروط في هذا الصدد هي ما يمكن أن نسميها بالشروط الإيمانية، وهي أمور باطنية نفسية تتمثل فيما يعقد الإنسان عليه قلبه في بداية الفعل من تصفية الإرادة، وتصحيح التوجه والقصد، من خلال التجرد التام من الهوى والحظوظ الشخصية وما يتصل بذلك من المعاني التي لا يمكن الارتقاء إليها ولا استدامتها إلا من خلال التحقق بمقام الشهود الذي تتلاشى به بالمرة حظوظ النفس بالمصطلح الصوفي العرفاني التربوي، وهي ما يضمن التفاعل القوي والإيجابي مع مضامين الدعوة، ويتيح القدرة على الاستمرار في العمل، ويقوي الحافز بتجاوز الصعاب والمثبطات.
وهذا الأمر هو ما سعى الشرع إلى تحقيقه بتركيزه على النية وما أوجبه من تصفيتها والاشتغال بإصلاحها قبل البدء في الأفعال، حتى لا تكون العناية بالفعل فقط، وإنما بالنية التي ينبثق عنها ذلك الفعل.
والمقصود هنا حديث النية المشهور الذي دأب العلماء -ولاسيما المحدثون- على بدء كتبهم به، وهو ما أخرجه الشيخان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه»(4).
والمعنى المراد من هذا الحديث في هذا الباب أن يكون لدى المبلغ هدف واضح يسعى إليه، ويجرد نيته وإرادته لأجله، وليس ذلك إلا ما ذكره القرآن الكريم على لسان شعيب عليه السلام الذي قال لقومه: ﴿إِنُ ا۟رِيدُ إِلَّا اَ۬لِاصْلَٰحَ مَا اَ۪سْتَطَعْتُۖ وَمَا تَوْفِيقِيَ إِلَّا بِاللَّهِۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُۖ ﴾ هود: 88.
ولابد أولا لتحقيق هذا الهدف من معرفة حقيقته بالمجتمع وأوضاعه، وتشخيص آفاته وانحرافاته، وتحديد نوعها، ودرجة خطورتها، وتمييز ما يدخل منها في العقيدة أو السلوك أو المعاملات أو غير ذلك، وذلك لتكون خطة الإصلاح واضحة.
ومما يحتاجه المبلغ في هذا الصدد بما يمثل زاده في الطريق القوة النفسية التي يكون بها قادرا على ملازمة الصدق في التبليغ، والتحقق بالشجاعة والصبر في الطريق، من غير مداهنة ولا مصانعة، ولا يكون ذلك إلا بخشية الله وحده دون سواه، وهو ما لا يكاد يتحقق إلا في العلماء كما يدل على ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَي اَ۬للَّهَ مِنْ عِبَادِهِ اِ۬لْعُلَمَٰٓؤُاْۖ ﴾ فاطر: 28.
واقتران الخشية بالعلم مرده إلى أن العالم بالله حقا لا يرى في الكون فاعلا على الحقيقة إلا الله، فهو المقدم والمؤخر، والمعز والمذل، والمعطي والمانع، والضار والنافع.. ومن عرف الله بذلك لم يتعزز بغيره، ولم يتذلل لسواه، ولم يرج النفع من غيره، ولم يستكشف الضر من سواه، وكان أمله معلقا به في كل حال، ولهذا كان المبلغون عن الله هم المتحققين فعلا بهذا الوصف بشهادة الله لهم في قوله تعالى: ﴿اِ۬لذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَٰلَٰتِ اِ۬للَّهِ وَيَخْشَوْنَهُۥ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَداً اِلَّا اَ۬للَّهَۖ وَكَف۪يٰ بِاللَّهِ حَسِيباٗ﴾ الأحزاب: 39.
ثانيا: الانطلاق في عملية التبليغ لا باعتبارها عملا فرديا أو شخصيا، وإنما باعتبارها مشروع أمة، وواجبا على كل الجماعة بصفة عامة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب مجموع الأمة بقوله: «بلغوا عني ولو آية» الحديث(5) . ويقول: «ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب». الحديث(6)، ويقول: «نضر الله امرأ سمع منا حديثا، فحفظه فأداه إلى من هو أحفظ منه، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه(7)».
وإذا كان الخطاب من النبي صلى الله عليه وسلم هكذا عاما فإن معناه أنه يعم الجميع، بحيث يشمل الخاص والعام، والعالم وغير العالم، وقوله صلى الله عليه وسلم فيه: «فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» دليل على ذلك.
وما يفهم من هذا -علاوة على ذلك- هو أن التبليغ مادام يطالب به الجميع هو بلا شك مستويات كثيرة، وليس مستوى واحدا، إذا لا يمكن أن يطالب العالم بتبليغ يكون هو وغيره فيه سواء.
ولذلك وجب أن نفهم أن تبليغ العالم أعلى من غيره وأرقى، وأن ما يميزه لابد أن يكون زائدا به عمن سواه.
وبيان ذلك في الشرط الموالي، شرط التمكن العلمي، وهو الشرط الثالث ضمن هذه الشروط، والمقصود به التمكن التام من مادة التبليغ بالاطلاع الجيد، والاستيعاب الشامل، والفهم الصحيح، ثم لا يكفي ذلك إلا باقترانه بالقدرة على الإقناع والحجاج، وقرع الحجة بالحجة، والنفاذ إلى قلوب المخاطبين، بقوة التأثير، وسلطان الدليل، لأنه لا إكراه في الدين، ولأن الله تعالى لا يريد أعناقا خاضعة، وإنما قلوبا مذعنة منيبة:إِن نَّشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ اَ۬لسَّمَآءِ اَ۟يَةٗ فَظَلَّتَ اَعْنَٰقُهُمْ لَهَا خَٰضِعِينَۖ﴾ الشعراء: 4. وفي آية أخرى: إِنَّ فِے هَٰذَا لَبَلَٰغاٗ لِّقَوْمٍ عَٰبِدِينَۖ﴾ الأنبياء: 106.
وهذا يقتضي التدريب على فن التأثير والإقناع، وإحكام صنعة الخطاب والبرهان، وكل ذلك قصه القرآن الكريم علينا من طرائق الحجاج التي كانت للرسل مع أقوامهم، خاصة وأن الدين حجة بنفسه، قوي بحقائقه، وهذه القوة هي زاد المبلغ في الإقناع إذا عرف كيف يفيد منها.
رابعا: فقه التنزيل، وهذا أحد الشروط الأساسية في التبليغ، لأنه لا يكفي أن يعرف الإنسان الحق ووجهه، فيخاطب به في أي وقت كان، ومع أي كان، من غير حكمة ولا تبصر، وإنما المطلوب أن يعرف ما يقال في الوقت المناسب، ومع الشخص المناسب، وبالكيفية المناسبة، روى البخاري عن علي كرم الله وجهه أنه قال: «حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله»(8)، أورد ذلك تحت باب من خص بالعلم قوما دون قوم، كراهية أن لا يفهموا.
ويسمى هذا عند أهل التربية والتسليك بربانية التعليم، التي تعني أن يعطي كل إنسان ما يوافقه ويناسبه من الحكمة، انطلاقا من قوله تعالى: ﴿وَلَٰكِن كُونُواْ رَبَّٰنِيِّۧنَ بِمَا كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اَ۬لْكِتَٰبَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ﴾ آل عمران: 79، والربانيون الذين جمعوا مع العلم البصارة بسياسة الناس.
وهذا باب واسع يدخل في خانة الحكمة، ومراعاة أحوال المخاطبين، واعتبار الواقع، وما يكتنفه من التحديات والتجاذبات والتيارات..
خامسا: الشروط الأخلاقية وهي ذات أهمية بالغة في هذا الباب، والمراد بها ما ينبغي أن يكون عليه المبلغ من مطابقة أحواله لحقيقة ما يبلغه ويدعو إليه، حتى يكون مسموع الكلمة، نافذ التأثير، وهو ما كان عليه حال نبينا صلى الله عليه وسلم الذي وصفه الله تعالى بقوله: ﴿لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٞ مِّنَ اَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُومِنِينَ رَءُوفٞ رَّحِيمٞۖ﴾ التوبة: 128، وقال أيضا: فَبِمَا رَحْمَةٖ مِّنَ اَ۬للَّهِ لِنتَ لَهُمْۖ وَلَوْ كُنتَ فَظّاً غَلِيظَ اَ۬لْقَلْبِ لَانفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِے اِ۬لَامْرِۖ﴾ آل عمران: 159، وقال أيضا: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٖ﴾ القلم: 4.
والقول في هذا واسع لا تسمح هذه المقالة بالتفصيل فيه.
سادسا وأخيرا: ضرورة التيقن بأن الرسالة وصلت، وأن مضامين التبليغ إلى القلوب نفذت، وبالمراد والمطلوب ظفرت، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «ألا هل بلغت» أكثر من مرة، أحيانا مرتين، وأحينا ثلاث مرات، تأكيدا للبلاغ وحرصا على الإنجاح والنفاذ.
وتفسير ذلك أن المبلغ في حقيقته إنسان يتفاعل، وداع إلى الهدى والحق يتعارك، بحرقة وحرارة، وحرص بالغ ومرارة، وليس آلة صماء، أو ساعي بريد بارد ومحايد لا يهمه هل نفذت حجته، ونجحت هدايته، أم لا؟
وهذا التفاعل وحمل الهم على هذا النحو هو ما يدفع المبلغ إلى الانشغال الدائم بالنتائج والآثار، وقبل ذلك بسلامة وسائله، وصحة طرائقه، وصفاء رؤيته لبيئته وواقعه، وحسن تقديره لمتغيراته وتحدياته، بما يتطلب اليقظة التامة، والنظرة المستوعبة والثاقبة، والعمل على الانخراط في التكوينات المستمرة والمتكررة، مع الاجتهاد والتجديد، والمواكبة والتحديث، على مستوى الخطاب والمضمون والوسائل وكل شيء، ودائما في إطار التعلق الكامل بالله، وإلجاء الظهر إليه، وحصر استمداد التوفيق والعون عليه، حتى يكون الأمر كله به سبحانه وله.
ومن كان كذلك حقا وصدقا كان الله له وليا، وبه حفيا، وكفى بالله وكيلا.
والحمد لله رب العالمين.
(1) . جزء من حديث: الحلال بين، والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات: كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة: إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب . أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الإيمان، باب: فضل من استبرأ لدينه.
(2) . ابن أبي حاتم الرازي: تفسير القرآن العظيم، تحقيق: أسعد محمد الطيب، المملكة العربية السعودية: مكتبة نزار مصطفى الباز- ط. الثالثة: 1419 هـ، ج 4- 1271.
(3) . عبد الرزاق الصنعاني: التفسير تحقيق: محمود محمد عبده - بيروت: دار الكتب العلمية – ط. الأولى: 1419هـ، ج 44-2.
(4) . أخرجه البخاري. ومسلم وغيرهما واللفظ لأبي داود.
(5). هو طرف حديث: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل.
(6) . هو جزء من حديث: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب، أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب العلم باب: ليبلغ العلم الشاهد الغائب.
(7) . أخرجه أحمد في مسنده تحقيق: أحمد محمد شاكر القاهرة: دار الحديث – ط. الأولى: 1416هـ، 1995م، ج 4- 172، والدارمي في مسنده: باب الاقتداء بالعلماء من المقدمة، وابن ماجه في سننه: أبواب السنة، باب من بلغ علما.
(8) . أخرجه البخاري في صحيحه، رقم الحديث: 127