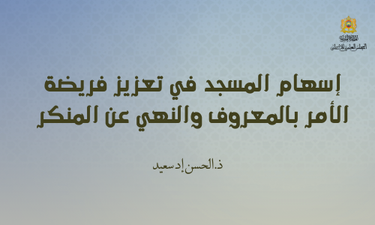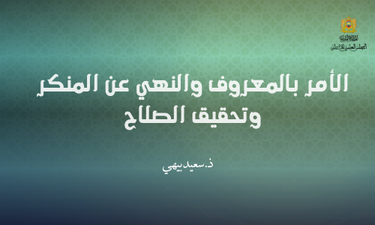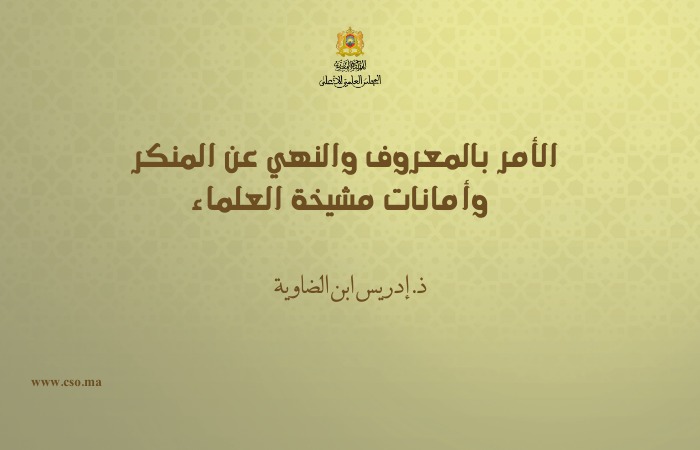الحمد لله الذي جعل الدين مبنيا على أسس متينة، ومحكما بقواعد رصينة، ومشتملا على حِكَم ثمينة، فكان جامعا لكل معاني الخير والفضل، شاملا لصنوف اليسر والعدل، والصلاة والسلام على من بلّغ الدين بكماله، وجاء بالإسلام على تمامه، وبيّن طريق تبليغ الدين، لمن أراد أن يكون من المهتدين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله الأطهار، وصحابته الأخيار، الذين نشروا الدين في كل الأمصار، والتابعين لهم ما كور الليل على النار.
أما بعد؛ فإن الدين شرعُ الله الذي اختاره للعباد، ليحققوا به سعادة الدارين ويحصلوا بتطبيقه على المراد، بما اشتمل عليه من المنافع والمصالح، وبما يحقق للعبد من سعادة تامة وعيش صالح، وما فيه من الحقائق التي تزيل غياهب الجهل والشبهات، وما انطوى عليه من الدقائق الكاشفة لكل الترهات والخرافات. وإن الدعوة إلى الله من أفضل القرب؛ وتبليغ الدين ببصيرة من أجل ما له المرء انتدب، بيد أن المبلغ لابد أن يكون على بينة بما يقوم به، وأن يستشعر المنزلة التي تبوأها، وأن يدرك مكانة أمر تبليغ الدين، وأنه ليس أمرا هينا يقوم به كل من هب ودب، أنى حصل وكيفما اتفق، وإنما للتبليغ ضوابط وقواعد، وأسس تثمر الفوائد وتنتج الفرائد، وشروط بها يتم الظفر بالمقصود، ومناهج بمراعاتها يحصل الهدف المنشود.
فالتبليغ لدين الله إذن من أعز ما يقوم به الإنسان، ومن أشرف ما ينطق به اللسان، كيف لا وقد قال صلى الله عليه وسلم: « بلغوا عني ولو آية»، فتضمن هذا المقطع من الحديث تكليفا [بلغوا]، وتشريفا [عني]، وتخفيفا [ولو آية]، ونادى ربنا الكريم رسوله محمدا عليه السلام آمرا إياه أن يبلغ ما أنزل إليه فقال عز وجل:
﴿يَٰٓأَيُّهَا اَ۬لرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَۖ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَٰتِهِۦۖ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ اَ۬لنَّاسِۖ إِنَّ اَ۬للَّهَ لَا يَهْدِے اِ۬لْقَوْمَ اَ۬لْكٰ۪فِرِينَۖ﴾ (1) مما يبين أن التبليغ للدين أمره عظيم، وخطره جسيم، لأنه إحياء لمهمة الأنبياء، وسير على سنة المرسلين، وبيان عن رب العالمين؛ ومن أجل إيضاح أهم الأسس التي لابد من مراعاتها، ولا عدول عن بيانها، لمن أراد تبليغ الدين بوجه ينفع المسلمين ويحقق سعادتهم، حتى ينعموا بالحياة الطيبة في الدنيا قبل الآخرة، لكل هذا كتبت هذا البحث الموسوم بـ: «أسس تبليغ الدين لما ينفع المسلمين»، وقد جعلته راجعا إلى ثلاث وقفات في كل من: التمهيد وأسس التبليغ والخاتمة.
أشير في الوقفة الأولى الممهِّدة، إلى أن الدين الإسلامي هو الدين الذي اختاره رب العالمين للناس أجمعين، وأنه جاء بالرحمة لكل الورى، سالكا بهم طريق الأمام لا الرجوع إلى الوراء، وأبين في الوقفة الثانية الأسس التي لابد منها في تبليغ الدين لما ينفع المسلمين، شارحا لها بما يوضح معناها ويكشف عن مغزاها، وأخيرا أضع في الوقفة الأخيرة خاتمةً تتضمن إشارات وخلاصات، فأقول وبالله التوفيق، وعليه اعتمادي في كل جلي أو دقيق:
الوقفة الأولى: في بيان كون الإسلام دينا عالميا قد جاء بالرحمة والسعادة للإنسانية كلها
هذا الدين الإسلامي الحنيف دين عالمي، قد ارتضاه الإله الكريم لعباده، وجاء به النبي الأمين عليه السلام رحمة وهدى للعالمين، قال تعالى: ﴿وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا رَحْمَةٗ لِّلْعَٰلَمِينَ﴾ (2).
يقول الإمام الرازي: «النبي عليه السلام كان رحمةً في الدين وفي الدنيا، أما في الدين فلأنه عليه السلام بُعث والناس في جاهلية وضلالة، فبعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم حين لم يكن لطالب الحق سبيل إلى الفوز والثواب، فدعاهم إلى الحق وبين لهم سبيل الثواب، وشرع لهم الأحكام وميز الحلال من الحرام، وأما في الدنيا فلأنهم تخلصوا بسببه من كثير من الذل والقتال والحروب ونُصروا ببركة دينه»(3).
وقد عُدّ كونُ النبي صلى الله عليه وسلم -وحده دون غيره من الرسل- رسولا للعالمين من الأمور التي أكرمه الله بها واختص بها، فعن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « أعطيتُ خمسا لم يعطَهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، وأعطيت الشفاعة » (4).
ومن ثمة فلا يوجد هدى مبين، ولا شرع مستقيم، يجب على البشرية كلها أن تتبعه وتعبد الله به، وتحقق على منهاجه سعادتها في الدنيا والآخرة سوى دين الإسلام، ومن ابتغى دينا غير الإسلام فقد تطلّب في الماء جذوة نار، ولن يكون لعمله أي اعتبار، كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ اَ۬لِاسْلَٰمِ دِيناٗ فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُۖ وَهُوَ فِے اِ۬لَاخِرَةِ مِنَ اَ۬لْخَٰسِرِينَ﴾ (5).
يقول الإمام أبو السعود في هذه الآية: «والمعنى: أن المعرضَ عن الإسلام والطالبَ لغيره فاقدٌ للنفع واقعٌ في الخسران، بإبطال الفطرةِ السليمةِ التي فُطر الناسُ عليها» (6).
وبالجملة، فإن القرآن الكريم يربط الإنسانية بخالقها الجليل، لتكون وجهتها واحدة، فيسهل جمعها واتفاقها؛ إذ بتوحيد الله والإيمان به تكتسب قيمة وجودية، وتنقذ نفسها من العدم والعبث في الدنيا، والخسران في الآخرة؛ لذلك فإن تفويض أمر الخلق لصانع واحد يسهل أمر اجتماعها ووحدتها (7).
ومن هاهنا فقد جاءت في القرآن الكريم آياتٌ تدعو إلى الإسلام، كما سلك القرآن في هذه الدعوة مجموعة من الأساليب التي تحقق المقصود، وترغب كل الناس في الدخول في رحاب الإسلام بفضل ما اشتمل عليه من السماحة والتيسير ورفع الحرج وغير ذلك، كما أن هذا الدين مشتمل على ما ينفع المسلمين ويحقق مصالحهم الحقيقية في الدنيا، ويبشرهم بالفضل والخير والأجر والجنة في الآخرة، إن هم حققوا ما طلب منهم من الإيمان المستقر الذي لا يكدره شيء، والعمل الصالح الذي فيه الإخلاص للخالق عز وجل.
الوقفة الثانية: في إيضاح أسس تبليغ الدين لما ينفع المسلمين
إن من انتصب لتبليغ الدين والدعوة إلى الله وتبيين حقائق الإسلام لعموم المسلمين، يجب عليه أن يبني عمله الجليل هذا على أسس وضوابط، تصونه من العبث في التبليغ، وتقيه الزلل في الدعوة، وتوضح له المعالم والمناهج التي يلزمه أن يقتفي أثرها ويستنير بهُداها؛ حتى يكون لتبليغه أثر صالح، وينتج عن عمله نفع واضح؛ ومن ثمة فإن المبلغ ليس كغيره من عامة الناس، بل شأنه أن يكون في صدارة كل خير، وأن ينأى بنفسه عن كل ضير، وحريٌّ به أن يتصف بأوصاف كريمة وأخلاق فاضلة، كما يجب عليه ويلزمه حتما أن يكون على علم بما يدعو إليه، وأن يكون قدوة في خلقه وأفعاله، حيث يدعو بحاله قبل مقاله، ومن هاهنا يكون لديه منهج محكم وسير متوازن، به يتمكن من تبليغ الدين بكل اقتدار، ويحقق النتائج المطلوبة دون عثار، وإن تفصيل هذه الأسس التي ينبغي أن يكون عليها المبلغ لينفع الناس أمر يحتاج إلى بيان، واستنطاق جنان وترقيم بنان؛ ولهذا فإنني سأكتفي هنا بإشارات مبصّرة، آمِلا أن تكون إن شاء الله للمنهج المطلوب مقررة، وهذا ما سأذكره في هذه الأسس الثمانية، راجيا أن تكون في الموضوع كافية، وبزبدة ما تناثر في الكتب وافية، مبينا مضامينها في الكلمات الآتية:
الأساس الأول: العلم والبصيرة
من المسائل المعروفة عند المناطقة أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره وتصويره، وبيان هذه القاعدة في معرض أسس التبليغ: أن المبلغ للدين ينقل معاني القرآن والحديث ودلالتهما إلى الناس، فكان من أوجب الواجبات عليه أن يستوعب تلك المعاني، وأن يفهم تلك الدلالات على أكمل وجه وأتم صورة، حتى يستطيع أن ينقلها إلى المستمعين من غير تحريف أو تغيير، أو العدول بها عما يحقق مقاصدها ويثمر نتائجها.
ولهذا فإن المفروض في المبلّغ أن يكون عالما بما يدعو إليه، على بصيرة بما يورده من نصوص وأقوال أثناء عرض الإسلام، وأن يكون متمكنا من مجال الدعوة، قد اكتسب المراس في طرقها وأساليبها، له زاد علمي يستطيع به دحض الشبهات والرد على كل التهم التي يوردها أهل الباطل، ويريدون جعلها حاجزا مانعا أمام الدعوة إلى الله؛ ومن ثمة فالجاهل لا يفيد في التبليغ السديد، لأنه فاقد للرأي الرشيد، إذ إنه سيفسد من حيث يظن أنه يصلح، كما قيل:
ذاك الذي بغير علم يعبد * لا يصلح العمل لكن يفسد
ولا شك أن الدعوة إلى الله عبادة عظيمة، فكان مما تقتضيه أن يكون ممارسها على بينة من أمره، قد ملك البرهان والحجة على ما يقول، وقد سمى القرآن الكريم هذا العلم المطلوب في الدعوة بصيرةً، فقال تعالى: ﴿قُلْ هَٰذِهِۦ سَبِيلِيَ أَدْعُوٓاْ إِلَي اَ۬للَّهِۖ عَلَيٰ بَصِيرَةٍ اَنَا وَمَنِ اِ۪تَّبَعَنِےۖ وَسُبْحَٰنَ اَ۬للَّهِ وَمَآ أَنَا مِنَ اَ۬لْمُشْرِكِينَۖ﴾ (8).
وقد أحسن الإمام البقاعي في بيان معنى هذه البصيرة بقوله: «{على بصيرة} أي حجة واضحة من أمري بنظري الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة وترك التقليد الدال على الغباوة والجمود؛ لأن البصيرة المعرفة التي يتميز بها الحق من الباطل ديناً ودنيا، بحيث يكون كأنه يبصر المعنى بالعين» (9).
وإن في الأمر بالقراءة والتعلم قبل الاشتغال بدعوة الناس إلى الإسلام وتبليغ شعائر الدين لهم إشارةً وتلميحاً لأهمية العلم قبل التبليغ، قال تعالى: ﴿اَ۪قْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ اَ۬لذِے خَلَقَۖ﴾ (10)، ففي هذا التقديم تنبيه على أن الدعوة والتبليغ لأحكام الدين لابد أن يتقدمهما العلم والمعرفة خصوصا بالأمور التي يقصد الإنسان تبليغها وإيصال أهدافها وحقائقها للناس.
وإن مما يفتح بابا كبيرا من الشر على الأمة أن يتصدر الجاهل مجالس العلم ويعد نفسه من أهل البيان والبلاغ، فيثق العامة بأقواله ويأخذون بآرائه فيهلكهم بجهله وضلاله، سواء كان قاصدا لذلك وهذا منكر عظيم، أو غير قاصد فيكون كمن يروم النفع وهو سائر في طريق الفساد، كما قيل:
رام نفعا فَضَرَّ من غير قصد * ومن البـر ما يكون عقوقا
ولهذا أخبر صلى الله عليه وسلم أنه عندما يموت العلماء يبقى أهل الجهل في الأرض يدّعون العلم والفهم في الدين فحينما يُسألون يجيبون بالمنكر والخراب فيَضلون هم أولا ويُضلون غيرهم ثانيا، ونص الحديث: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا» (11).
قال الإمام ابن أبي جمرة في ذكر ما يستفاد من الحديث: «فيه دليل على أن أخذ الأشياء على غير ما أحكمته الشريعة لا توجد لها فائدة، بل تنعكس الفائدة بالضرر؛ لأن العوام لم يتخذوا هؤلاء الجهال رؤساء إلا لأجل الفائدة التي عهدوها ممن تشبهوا بهم، وهو الإرشاد لما يصلحهم، فلما لم تكن فيهم الشروط التي أحكمتها الشريعة جاءهم إذ ذاك ضد ما أرادوه وهو الضلال» (12).
الأساس الثاني: القدوة الحسنة بالأفعال قبل الأقوال
من الأسس التي يقوم عليها أمر تبليغ الدين الانطلاق من النفس ومحاسبتها، حيث يأخذ المبلغ عهدا مع نفسه أن يكون أولا مطبقا لما يمليه على الآخرين، وعاملا بذلك في نفسه قبل تبليغه لغيره، حيث تترجم أفعاله وسلوكه وتصرفاته ما ينطق به ويدعو إليه، ولعمري إن الدعوة بالحال أوقع في النفس من الدعوة بالمقال، ومن هنا فلا يمكن أن تعطي دعوة المبلغ النتائج المطلوبة والثمار المقصودة إلا إذا كانت أفعاله تصدق أقواله؛ وذلك بأن يكون قدوة بأفعاله وأحواله قبل أن تجري الدعوة على لسانه وأقواله، وهذا أمر جار في دعوة المسلمين وغيرهم، وفي غيرهم يكون الأمر أشد، فإن كان يعمل بما يبلغه ويبينه للناس كان ذلك أدعى لقبول قوله، وإلا فلا معنى للدعوة أصلا، وقد قيل:
من خالفت أقوالُه أفعالَه * تحولت أفعالُه أفعى له
وقال الله تعالى: ﴿وَمَنَ اَحْسَنُ قَوْلاٗ مِّمَّن دَعَآ إِلَي اَ۬للَّهِ وَعَمِلَ صَٰلِحاٗ وَقَالَ إِنَّنِے مِنَ اَ۬لْمُسْلِمِينَۖ﴾ (13).
ولفظ [مَنْ] في الآية وإن ذكر بعض المفسرين أن المراد به رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان غاية في الدعوة حالا ومقالا، لكن يمكن أن يعمم اللفظ وينسحب على كل من يدعو إلى الله ببصيرة ويعمل الصالحات، ويكون أسوة بفعله قبل قوله.
وعلى هذا العموم نبه الإمام ابن عطية بقوله: «وهو لفظ يعم كل من دعا قديما وحديثا إلى الله تعالى وإلى طاعته من الأنبياء والمؤمنين، والمعنى: لا أحدَ أحسنُ قولا ممن هذه حاله» (14).
الأساس الثالث: اعتماد القول اللين والملاطفة في الخطاب
القول اللين والمنطق الجميل والملاطفة في الخطاب من الأسس المطلوبة في التبليغ؛ لما لها من تأثير بالغ في النفوس، والانطلاق من التشديد في الألفاظ والتجريح يتنافى مع الحكمة المطلوبة في الدعوة، قال تعالى: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٖ مِّنَ اَ۬للَّهِ لِنتَ لَهُمْۖ وَلَوْ كُنتَ فَظّاً غَلِيظَ اَ۬لْقَلْبِ لَانفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِے اِ۬لَامْرِۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَي اَ۬للَّهِۖ إِنَّ اَ۬للَّهَ يُحِبُّ اُ۬لْمُتَوَكِّلِينَۖ﴾ (15).
والمعنى: برحمةٍ من الله لنت لهم يا رسول الله، فكلمة [ما] زائدة بعد الباء، ولم تكف حرف الباء عن عمل الجر، عملا بقول ابن مالك رحمه الله:
وبعد من وعن وباء زيد ما * فلم يعق عن عمل قد علما
قال العلامة ابن عاشور في معرض بيان اللين الذي اتصف به الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته وتبليغه: «اللين هنا مجاز في سعة الخُلُق مع أمة الدعوة والمسلمين، وفي الصفح عن جفاء المشركين وإقالة العثرات، فخلق الرسول مناسب لتحقيق حصول مراد الله تعالى من إرساله، لأن الرسول يجيء بشريعة يبلغها عن الله تعالى، فكان لينه رحمة من الله بالأمة في تنفيذ شريعته بدون تساهل، وبرفق وإعانة على تحصيلها، فلذلك جعل لينه مصاحبا لرحمة من الله أودعها الله فيه، إذ هو قد بعث للناس كافة، ولكن اختار الله أن تكون دعوته بين العرب أول شيء؛ لحكمة أرادها الله تعالى في أن يكون العرب مبلغي الشريعة للعالم» (16).
قال عز وجل لما أرسل موسى وأخاه هارون لدعوة فرعون مع ما وصل إليه من الطغيان والكبر والجحود: ﴿فَقُولَا لَهُۥ قَوْلاٗ لَّيِّناٗ لَّعَلَّهُۥ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْش۪يٰۖ﴾(17).
قال المفسرون والمعنى: قُولا له قول لطيفا رقيقا؛ وذلك بأن تكون البداءة معه بالرغبة قبل الرهبة ليلين بها ويستجيب، ومن ثمة قال بعض العارفين: يا رب هذا رفقك لمن عاداك، فكيف رفقك بمن والاك؟
ومن هذه النصوص ينجلي أن من الأسس المهمة في تبليغ الدين دعوة الناس بالرحمة واللين، وتقريب شعائر الدين إليهم بحكمة ويسر؛ فإن هذا أدعى للانقياد والقبول، وأما من شدد على الناس في القول، وأدخل عليهم العسر والعنت حسا أو معنى، فلا شك أنهم سينفرون من دعوته، وسينفضون من حوله تاركين ما جاء به ولو كان في نفسه صالحا مفيدا.
الأساس الرابع: البدء بالأهم قبل المهم
من أسس التبليغ والدعوة التركيز على الأصول قبل الفروع، والاهتمام بالكليات أكثر من الجزئيات، وتقرير القواعد قبل الخوض في اللطائف والفوائد، وبيان الواجبات قصد امتثالها والمحرمات قصد تركها قبل توضيح السنن والمكروهات، قال تعالى مبينا الوظيفة الأولى لجميع الرسل: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِے كُلِّ أُمَّةٖ رَّسُولاً اَنُ اُ۟عْبُدُواْ اُ۬للَّهَ وَاجْتَنِبُواْ اُ۬لطَّٰغُوتَۖ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَي اَ۬للَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ اِ۬لضَّلَٰلَةُۖ فَسِيرُواْ فِے اِ۬لَارْضِ فَانظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ اُ۬لْمُكَذِّبِينَ﴾ (18).
فذكر الله عز وجل في هذه الآية الكريمة: أنه بعث في كل أمة رسولا لعبادة الله وحده، واجتناب عبادة ما سواه، وهذا هو معنى «لا إله إلا الله» لأنها مركبة من نفي وإثبات، فنفيها هو خلع جميع المعبودات غير الله تعالى في جميع أنواع العبادات، وإثباتها هو إفراده تعالى بجميع أنواع العبادات بإخلاص، على الوجه الذي شرعه عن طريق رسله.
وقد جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: «إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، فإن هم طاعوا لك بذلك، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم طاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم طاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب» (19).
وأمر تقديم الدعوة إلى الإسلام وتحقيق معنى الشهادتين على غيرها من الأركان والواجبات أمر معروف في الفقه أيضا، ويرحم الله الإمام ابن عاشر الذي جعل الشهادتين شرطا لباقي الأركان والقواعد فقال:
قواعد الإسلام خمس واجبات * وهي الشهادتان شرط الباقيات
قال ميارة في شرحه الكبير: «قوله [شرط الباقيات] صفة الشهادتين، وكونهما شرطا في الخصال الباقية صحيح» (20).
كما أن أمر تقديم الفرائض على النوافل مشهور، فقد جاء في صحيح البخاري: «وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه»(21)، فالحديث صريح في أن الفرائض مقدمة على النوافل، وآية ذلك أن النوافل ليس لها أثر إلا لمن حصل الفرائض كما قال الإمام ابن بطال: « وفيه -الحديث- أن النوافل إنما يزكو ثوابها عند الله لمن حافظ على فرائضه وأداها» (22).
الأساس الخامس: التفكير والتخطيط القبلي
إن التبليغ ليس عملية سهلة يمكن أن يقوم بها كل الناس بيسر وسهولة، وإنما هو عمل شاق يحتاج -زيادة على ما تقدم- إلى حنكة ودربة ومراس، فلئن كان خبراء التربية والباحثون في البيداغوجيات التعليمية المعاصرة يوصون بضرورة التخطيط والترتيب للدرس قبل تقديمه -صونا للزمن والحصص من الارتجالية التي قد تؤثر على بعض المحاور، وتنحو بالدرس جهة الاستطراد والخروج عن الموضوع- فإن مراعاة هذا التخطيط في التبليغ أشدّ، واعتماد الترتيب لما سيقال للناس أسدّ، ومن هنا فمن الواجب على المبلغ استحضار ما ينبغي قوله وما ينبغي الإحجام عنه، ومن اللازم تقديم ما حقه التقديم، وتأخير ما حقه التأخير، ومن الآكد معرفة أحوال الناس ومراتبهم والاندماج معهم في هموهم وما يشغل بالهم، كل هذا من أجل أن يكون للتبليغ أثر إيجابي في الواقع، ومتى حصل التبليغ من غير اعتبار هذه المقامات والأحوال من التفكير المسبق والتخطيط القبلي ذهب جهد المبلغ سدى، وكان عمله عبثا لا يليق بأهل العلم.
يقول الدكتور مصطفى بن حمزة: «وبسبب توقف التبليغ السليم على التفكير الجيد والنظر الثاقب الذي يستشرف العواقب، فقد كان من شرط النبوة الذكاء والفطانة، ما دام التبليغ يحتاج إلى عمليات ذهنية مختلفة، وما دام نجاحه متوقفا على وضع خطة ذكية محكمة للأداء، ومن قبل أن يوجه الداعي خطابه إلى المستهدف به، فإن ذلك يتطلب منه التحقق من تقنيات الأداء الكفيلة بتحقيق النتائج الإيجابية المتوخاة، كما يتطلب الموقف معرفة الفروق النفسية والاستعدادات الفردية التي يتسم بها المدعوون» (23).
الأساس السادس: تنبيه الأنام إلى محاسن الإسلام
القارئ للقرآن الكريم، والمتأمل في هذا الشرع الحكيم، والناظر في هذا الدين القويم، يجد كل ذلك يفيض حسنا وجمالا من جهات متعددة ونواح مختلفة، وإن ذكر محاسن الإسلام وبيان ما فيه من جمال يفضي إلى تحبيبه للمسلمين، كما يفتح المجال أيضا للمخالف إذا استشعر ما تضمنه الإسلام من تلك اللطائف، ومن أبرز مزايا الإسلام وخصائصه: التيسير ورفع الحرج وإزالة العنت والمشقة والتضامن والتسامح وغيرها من السمات الدالة على تلك المحاسن.
بل إن فقهاءنا جعلوا التيسير ورفع الحرج من أصول الشريعة وليس من محاسنها فقط، يقول الإمام الشاطبي (24): «إن الأدلة على رفع الحرج في هذه الأمة بلغت مبلغ القطع؛ كقوله تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج}، وسائر ما يدل على هذا المعنى؛ كقوله: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر}».
قال الإمام الطبري في تفسير قوله تعالى: ﴿وَجَٰهِدُواْ فِے اِ۬للَّهِ حَقَّ جِهَادِهِۦۖ هُوَ اَ۪جْتَب۪يٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِے اِ۬لدِّينِ مِنْ حَرَجٖۖ مِّلَّةَ أَبِيكُمُۥٓ إِبْرَٰهِيمَۖ هُوَ سَمّ۪يٰكُمُ اُ۬لْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِے هَٰذَا لِيَكُونَ اَ۬لرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَي اَ۬لنَّاسِۖ فَأَقِيمُواْ اُ۬لصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ اُ۬لزَّكَوٰةَ وَاعْتَصِمُواْ بِاللَّهِ هُوَ مَوْل۪يٰكُمْۖ فَنِعْمَ اَ۬لْمَوْل۪يٰ وَنِعْمَ اَ۬لنَّصِيرُۖ﴾ (25) ما نصه: «وما جعل عليكم ربكم في الدين الذي تعبّدكم به من ضيق، لا مخرج لكم مما ابتليتم به فيه، بل وسّع عليكم، فجعل التوبة من بعض مخرجا، والكفَّارة من بعض، والقصاص من بعض، فلا ذنب يذنبه المؤمن إلا وله منه في دين الإسلام مخرج» (26).
وبناء على هذا فإن الداعي يستثمر هذه المحاسن ويوظفها توظيفا حسنا حين يدعو الناس، فيبين لهم ما في الإسلام من الرحمة والعدل والصفح والسماحة، وما يشتمل عليه من التيسير ورفع الحرج وإزالة العنت، وما يحتوي عليه من المحبة والخير للناس ونشر الأمن، وما يدعو إليه من نبذ الكراهية والظلم والأذى، وغير ذلك من المحاسن العديدة التي اشتمل عليها هذا الدين الحنيف، حيث لو سمعها وأدركها المخالف لكان معجبا بهذا الدين، متشوقا ومتشوفا إليه، راغبا في الدخول في رحابه.
الأساس السابع: ضرب الأمثال
من الأسس المهمة التي ينبغي لمن اشتغل بتبليغ الدين أن يهتم بها ما يرتبط ببيان الحقائق وتقريب المسائل عن طريق ضرب الأمثال، وهذا ظاهر لمن تتبعه في كثير من مواضع القرآن الكريم وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام؛ لما للمَثَل من الأهمية في تقرير المعنى المراد في الذهن وترسيخه في النفس، حتى عدَّ بعضُ العلماء المثل من الأقسام التسعة التي اشتمل عليها القرآن الكريم على سبيل الإجمال، والتي جمعت في هذين البيتين (27):
ألا إنما القرآن تسعة أحرف * أتيتُ بها في بيت شعر بلا ملل
حلال حرام محكم متشابـــه * بشيــــــر نذير قصــــــة عظة مثل
وبناء على هذا فإنه يجدر بالمبلغ أن ينوع في أساليب دعوته، وأن يكون أساس ضرب الأمثال من المناهج المعتمدة عنده في تبليغ الدين؛ لأن بعض الأمور تكون عسيرة في تصورها، وعويصة في استيعاب أشكالها وصورها، مما يجعل المستمع ينفر منها، فيكون ضرب الأمثال وسيلة مناسبة للتقريب وطريقة صالحة للتحبيب.
ومن الأمثال التي ضربها القرآن الكريم في سياق بيان حال وحقيقة من يعبد إلها آخر قولُه تعالى: ﴿مَثَلُ اُ۬لذِينَ اَ۪تَّخَذُواْ مِن دُونِ اِ۬للَّهِ أَوْلِيَآءَ كَمَثَلِ اِ۬لْعَنكَبُوتِ اِ۪تَّخَذَتْ بَيْتاٗۖ وَإِنَّ أَوْهَنَ اَ۬لْبُيُوتِ لَبَيْتُ اُ۬لْعَنكَبُوتِۖ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَۖ﴾ (28).
قال الإمام ابن عطية: «شبه تعالى الكفار في عبادتهم الأصنام وبنائهم جميع أمورهم على ذلك بالعنكبوت التي تبني وتجتهد وأمرها كلها ضعيف، متى مسته أدنى هابة أذهبته، فكذلك أمر أولئك وسعيهم مضمحل، لا قوة له ولا معتمد» (29).
الأساس الثامن: التحلي بالصبر والثبات
إن تبليغ دين الله كما أراد الله أمر يحتاج إلى جهد وصبر ويقين؛ لأن الدعوة إلى الله مظنة التعب والمحن والمشاق؛ إذ هي مهمة الرسل، فمن وفقه الله أن يكون من أهلها، لابد أن يستحضر أن طريق التبليغ لأحكام الدين ليس مفروشا بالورود كما يقال، بل هو طريق النَّصَب ومجال الثبات وسبيل الصبر والتحمل، وإن من يقرأ القرآن الكريم في سياق حديثه عما جرى للرسل الكرام عليهم السلام مع أقوامهم، وكيف صبروا حتى ظفروا، يجد آيات كثيرة تشير إلى أن الصبر في الدعوة عموما وفي دعوة المخالفين خصوصا أمر لابد منه، لا تتحقق النتائج إلا به، وأكتفي هنا بإيراد آية هي تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وحض له على الصبر، ووعد له بالنصر، وهي أيضا نبراس لكل المبلغين لدين الله تعالى، الداعين إلى الإسلام بصبر وحكمة وبصيرة، والآية هي قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٞ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَيٰ مَا كُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّيٰٓ أَت۪يٰهُمْ نَصْرُنَاۖ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَٰتِ اِ۬للَّهِۖ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن نَّبَإِےْ اِ۬لْمُرْسَلِينَ﴾ (30)
يقول الإمام الطبري في تقريب معنى هذه الآية: «هذه تسلية من الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وتعزيةٌ له عما ناله من المساءة بتكذيب قومه إيّاه على ما جاءهم به من الحق من عند الله، يقول تعالى ذِكْرُه: اصبر على تكذيبهم إياك وما تلقى منهم من المكروه في ذات الله، حتى يأتي نصر الله، فقد كُذبت رسلٌ من قبلك أرسلتُهم إلى أممهم، فنالوهم بمكروه، فصبروا على تكذيب قومهم إياهم، ولم يُثنهم ذلك من المضيّ لأمر الله الذي أمرهم به من دعاء قومهم إليه، حتى حكم الله بينهم وبينهم» (31)
إذ التبليغ الناجح الذي يفيد الناس، وينتفع به المبلغ أيضا لابد له من شروط ثلاثة: أن تتقدمه بصيرة وعلم، وأن تصحبه حكمة وحِلم، وأن يعقبه صبر وسِلم.
ومن هاهنا فإن المبلغ لابد أن يكون صابرا محتسبا أثناء وبعد تبليغ الدين، وأن يتحمل الإساءة التي يمكن أن تصدر خصوصا من المخالف، حتى يصل إلى هدفه ويحقق غايته، ومن صبر ظفر، كما قيل:
أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته * ومدمنِ القرع للأبواب أن يلجا
الوقفة الثالثة: في خاتمة هذا البحث
بعد هذه الجولة المباركة في رحاب آي التنزيل، وما سقته من لطيف أقاويل أهل التأويل، مع ما أشرت إليه من هدي سيد المبلغين، وأفضل الخلق أجمعين، ضمن سياق البحث الذي يرتبط ببيان أسس التبليغ لما ينفع المسلمين، يمكن ذكر مجموعة من النتائج التي هي ثمرة البحث وخلاصة النظر، تكون خلاصة لما تمت مناقشته، وبيان ذلك فيما يلي:
- أولا: إن الدين الإسلامي دين عالمي، ليس لقوم دون قوم، وليس صالحا لفترة دون فترة، وإنما هو دين رب العالمين صالح لكل العالمين في كل زمان ومكان.
- ثانيا: إن القرآن الكريم جاء ليسعد البشرية كلها، فهو دستور جامع لكل خير وفضل، يتضمن الإيمان والأحكام والأمثال والوعظ والرقائق وغير ذلك، كما أن فيه جانبا متعلقا بمنهج الدعوة وأسس تبليغ الدين وأساليب نشر أحكام وشعائر الإسلام.
- ثالثا: إن تبليغ الدين ينبغي أن يكون من أجل إرشاد الناس وإسعادهم وبيان ما ينفعهم في الدنيا والآخرة، كل ذلك بالعلم والحلم والصبر والتيسير وغير ذلك من أسس الدعوة الناجحة.
رابعا: لابد لمن انتصب لتبليغ الدين للناس أن يبني بلاغه ويجعل تبيانه على أسس متينة، وقواعد رصينة، تحفظه من الخطأ والخطل، وتجنبه الوقوع في الوصم والزلل، ومن أهم هذه الأسس:
- أن يكون عالما بما يدعو إليه، على بصيرة بمجال الدعوة، وعلى بينة بأساليبها ومسالكها.
- أن يكون الداعي قدوة بفعله قبل قوله، فذلك أدعى لسماع دعوته والاستجابة لمراده.
- أن يستعمل الداعي الكلام الحسن، والقول اللين في دعوته، وأن يتجنب الألفاظ المنفرة.
- أن يراعي في دعوته الترتيب اللازم، فيبدأ بالأهم قبل المهم، ويشرع في ترسيخ الأصول قبل بيان الفروع.
- أن يجيد التخطيط القبلي وأن يحسن التفكير في الأمور التي سيقولها وينقلها إلى الناس، مستحضرا مآل كلامه، عارفا بأحوال وظروف المخاطبين.
- أن يحسن عرض الإسلام؛ وذلك ببيان ما فيه من محاسن، وما اشتمل عليه من خصال ومزايا تجعل الناس منجذبين إليه، راغبين في فهم أحكامه بغية الظفر بحِكَمه.
- أن ينوع في أساليب دعوته، فيستعمل إذا دعت الحاجة ضرب الأمثال لتقريب المراد إلى الأذهان.
- أن يكون أثناء دعوته متصفا بخلق الصبر والتحمل من أجل تحقيق المراد وبلوغ المقصود.
ومتى راعى المبلغ هذه الأسس المذكورة، واستحضرها في تبليغه للدين، كان بلاغه نافعا للناس، مزيلا ما يروج بينهم من الوهم والالتباس، منقذا للمخاطبين من الشر والزلل، سالكا بهم أهدى سبيل لنجاح العمل، مسهما في بيان الحياة الطيبة، التي هي ضالة كل حصيف أريب، وغاية كل عاقل لبيب.
وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب، والحمد لله رب العالمين.
(1) . سورة المائدة آية: 69.
(2) . سورة الأنبياء آية: 106.
(3) . مفاتيح الغيب بتصرف يسير، 22/ 193.
(4) . صحيح البخاري باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا» رقم الحديث: 438.
(5) . سورة آل عمران آية: 84.
(6) . إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، (2/ 55).
(7) . أصول تدبير الاختلاف في القرآن الكريم، ص: 93.
(8) . سورة يوسف آية: 108.
(9) . نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، 10/ 242.
(10) . سورة العلق الآية: 01، لأن المشهور في علوم القرآن أن سورة العلق أول ما نزل، وفي المسألة أقوال أربعة جمعها بعضهم بقوله:
واختلفوا في أول الذي نزل ××× من ذكر ربنا الكبير المتعال
مـزمـل مدثــر والقــلم ××× وســـورة العلق ذا المـــقــدم
(11) . صحيح مسلم باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان، رقم الحديث: 2673.
(12) . بهجة النفوس لابن أبي جمرة الأندلسي، 1/ 241.
(13) . سورة فصلت آية: 32.
(14) . المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، 5/ 15.
(15) . سورة آل عمران، آية: 159.
(16) . التحرير والتنوير، 4/ 145.
(17) . سورة طه، آية: 43.
(18) . سورة النحل آية: 36.
(19) . صحيح البخاري، باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا، رقم الحديث: 1496.
(20) . الدر الثمين، ص: 62.
(21) . صحيح البخاري، كتاب باب التواضع، رقم الحديث: 6502.
(22) . شرح صحيح البخاري لابن بطال 10/ 212، وهو الذي يعرف بين العلماء والباحثين بشرح [فيه وفيه] لكثرة استنباطاته للمسائل الفقهية والنكت العلمية في ألفاظ الحديث.
ثم إن هذا الذي ذكر في الحديث لا يتناقض مع ما أشار إليه بعض الفقهاء من أن النفل أحيانا يتقدم على الفرض في مسائل محصورة، وقد نظمها السيوطي بقوله:
الفرض أفضل من تطوع عابد ... حتى ولو قد جاء منه بأكثر
إلا التطهر قبل وقت وابتدا ... ء للسلام كذاك إبرا معسر
وذيل البيتين الإمامُ الخلوتي بقوله:
وكذا ختان المرء قبل بلوغه ... تمّم به عقد الإمام المكثر
ينظر: الأشباه والنظائر لجلال الدين السيوطي، 147/1.
(23) . أمانة التبليغ تأصيلا وتنزيلا، ص: 56.
(24) . الموافقات، 1/ 520.
(25) . سورة الحج: جزء من الآية: 76.
(26) . جامع البيان، 18/ 689.
(27) . ينظر: تاريخ القرآن الكريم، لمحمد طاهر بن عبد القادر الكردي، 11/1 .
(28) . سورة العنكبوت، آية: 41.
(29) . المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، 4/ 318.
(30) . سورة الأنعام، آية: 35.
(31) . جامع البيان، 183/7.