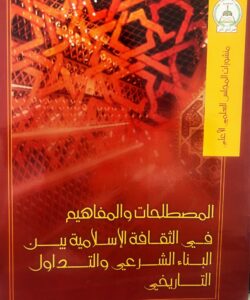موعظة المحاسبة مدخل لإصلاح النفوس
لا شك أن المسلم الصادق وفي إطار علاقته بخالقه تعالى، تشوش عليه نفسه التي بين جنبيه وتؤرقه، فلا يجد نفسه مرتاح البال مطمئن الحال وهو يتلبس بطاعته لربه، فكثيرا ما تعكر عليه نفسه المزاج عندما تزين له المعصية بين الحين والآخر، وتأمره باقتراف أنواع المعاصي والزلل، فلا يعرف ماذا يفعل؟ هل يطيع ربه أم يطيع نفسه؟ فما معنى هذه النفس؟ وكيف للمرء أن يروضها ليصل بها إلى طاعة ربه، ويستمر على ذلك إلى أن يلقاه على خير؟، وكيف سلك الربانيون الطريق في محاسبة ومجاهدة أنفسهم إلى أن اطمأنت أنفسهم في جنب الله؟.
إن من أهم العوائق التي تعوق الإنسان عن الوصول إلى حالة الاطمئنان في علاقته بربه والشعور بالسعادة القلبية، عائق النفس الأمارة بالسوء المتبعة للشهوة المائلة إلى الهوى، المجانبة للحق والهدى فيما تأمر به وتنهى عنه، قال الإمام الغزالي رحمه الله: » أعداء الإنسان ثلاثة: الدنيا والشيطان والنفس، فحارب الدنيا بالزهد فيها، وحارب الشيطان بدفعه، وحارب نفسك بمجاهدتها « ، وقال العلامة سعيد بابصيل رحمه الله: » النفس لطيفة ربانية خلقها الله سبحانه وتعالى قبل الأجساد بألفي عام، إذ هي الروح، فكانت حينئذ في جوار الحق وقربه فتستفيض من حضرته بلا واسطة، فلما أمرها الله أن تتعلق بالأجساد، عرفت الغير فحجبت عن حضرته لبعدها عنه، فلذا احتاجت لمذكر، قال تعالى: » وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين »، فهي قبل تعلقها بالجسد روحا وبعده نفسا، فلا يصح لعاقل الرضا عنها ولا موالاتها، كيف وقد قال تعالى حاكيا عن سيدنا يوسف عليه السلام : »وما أبرى نفسي » الآية . قال في روح البيان: أي لا أنزهها عن السوء ولا أشهد لها بالبراءة الكلية، قاله تواضعا لله تعالى وهضما لنفسه الكريمة لا تزكية لها، وعجبا بحاله في الأمانة، والمراد لا أنزهها من حيث هي هي، ولا أسند إليها فضيلة بمقتضى طبعها، بل بتوفيق الله تعالى، فإن جميع النفوس أمارة بالقبائح والمعاصي لاستلذاذها بها « .
فالنفس الأمارة بالسوء في حال الشهوة بهيمة، وفي حال الغضب سبع مفترس، وفي حال نزول المصيبة تراها طفلا صغيرا تبكي وتجزع ولا تصبر على ما أصابها مع جهلها لقضاء ربها وحكمه، وفي حال النعمة والسعة في العيش تراها فرعونا في التكبر والعلو في الأرض، وفي حال الجوع تراها مجنونا في التحير والدهش والصياح والغضب، وفي حال الشبع تراها مختالا متكبرا في البطر والطغيان وقضاء الشهوة والمرح، فهي كما قال القائل:
هي كحمار السوء إن أشبعته * بالشعير رمح وإن جاع نهق وحسبك ما تشاهده وتعاينه من حالاتها القبيحة ورداءة إرادتها وسوء اختيارها، وقد خلقت أمارة بالسوء، ميالة إلى الشر، فرارة من الخير، وأمرت بتزكيتها وتقويمها وتعديلها وقودها بسلاسل القهر إلى عبادة ربها وخالقها ومنعها عن شهواتها وفطامها عن لذاتها، فإن أهملتها جمحت وعصت وشردت ولم تظفر بها بعد ذلك واحتاجت إلى معالجة شديدة.
فلا تغفلن ساعة عن تذكيرها ومعاتبتها ولا تشتغلن بوعظ غيرك مالم تشتغل أولا بوعظ نفسك، فقد ورد أنه أوحى الله تعالى إلى عيسى عليه السلام: » يا ابن مريم عظ نفسك فان اتعظت فعظ الناس وإلا فاستحي مني »، رواه الإمام أحمد في الزهد عن مالك بن دينار. وقال عليه السلام: « أعدى الأعداء نفسك التي بين جنبيك » أخرجه الطبراني في الكبير، وقال محمد بن واسع رحمه الله: « من مقت نفسه في ذات الله أمنه الله من مقته ». ويقول أحد التابعين: « إن أول شيء يستحق أن تجاهده نفسك التي بين جنبيك، فإنك إن انتصرت على نفسك كنت على غيرها أقدر، وإن انهزمت أمام نفسك كنت عن غيرها أعجز »، وسئل بعض المشايخ عن الإسلام، فقال: » ذبح النفس بسيوف المخالفة « ، لأنها إذا اعتادت اللذات لا تنصرف إلى الطاعات إلا بالمجاهدات والتوبيخات الشديدة، ولذا سميت هذه الأمور سيوفا، وذبحها قهرها ونقلها عن هواها. وقال العلامة القشيري رحمه الله في الرسالة: « ومن غوامض آفات النفس ركونها إلى استحلاء المدح، فإن من تحسى منه جرعة حمل السماوات والأرضين على شفر من أشفاره؛ وأمارة ذلك أنه إذا انقطع عنه ذلك الشرب آل حاله إلى الكسل والفشل « . وقال جعفر: » من لم يتهم نفسه على الدوام ولم يخالفها في جميع الأحوال ويجبرها على مكروهها في سائر الأيام كان مغرورا، ومن نظر إليها باستحسان شيء منها فقد أهلكها ».
ومن هنا وجب القول بأن كل من كان أوفر عقلا وأجل قدرا عنده تعالى كان أبصر بعيوب نفسه، ومن كان أبصر بها كان أعظم اتهاما لنفسه وأقل إعجابا، إلا ما رحم ربي من النفوس التي عصمها، قال صاحب التأويلات النجمية: « خلقت النفس على جبلة الأمارة بالسوء طبعا حين خليت إلى طبعها، لا يأتي منها إلا الشر ولا تأمر إلا بالسوء، ولكن إذا رحمها ربها ونظر إليها بنظر العناية قلبها من طبعها وبدل صفاتها « . والعجب كل العجب من الذي تقوده نفسه وتأخذ به حيث تريد هي، ولا يأخذ بزمامها ولم يجعل لها لجاما. وذلك لأن النفس هي الحجاب الأعظم للعبد عن الله تعالى، وأن بمجاهدتها وقمعها وموتها تنال سعادة لقاء الله تعالى. قال بعضهم: « ما الحياة إلا في الموت »، أي ما حياة القلب إلا في إماتة النفس. وقيل: النعمة العظمى الخروج عن النفس لأن النفس أعظم حجاب بينك وبين الله تعالى ». وقد عبر الإمام أبو القاسم القشيري رحمه الله عن ذلك بقوله: » قتل النفس في الحقيقة التبري من حولها وقوتها أو شهود شيء منها، ورد دعاويها إليها، وتشويش تدبيرها عليها، وتسليم الأمور إلى الحق سبحانه بجملتها، وانسلاخها من اختيارها وإرادتها، وانمحاء آثار بشريتها عنها، فأما بقاء الرسوم والهياكل فلا خطر لها ولا عبرة « .
هذا وإن علماء الأخلاق ذكروا أن النفوس سبعة بحسب أوصافها، وإلا فهي واحدة: الأولى، النفس الأمارة بالسوء، وهي مأخوذة من قوله تعالى: « إن النفس لأمارة بالسوء »، وهي التي لا تأمر صاحبها بخير خالص من العلل، ولا ينافي ذلك أنها قد تأمر بخير معلول.
فتأمل تجد بأن أصل كل فتنة وبلية وفضيحة وهلاك وذنب وآفة وقع في خلق الله تعالى من أول الخلق إلى يوم القيامة، مرجعه إلى النفس الأمارة بالسوء إما بها وحدها أو بمعاونتها ومشاركتها ومساعدتها. فأول معصية لله تعالى كانت من إبليس اللعين، وكان سببه هوى النفس بكبرها وحسدها فعملت به ما عملت، ثم إن ذنب آدم وحواء عليهما السلام كان هو شهوة النفس وحرصهما على البقاء والحياة حتى اغترا بقول إبليس، فكان ذلك بعون النفس، فسقطا بذلك من جوار الله تعالى وقرار الفردوس إلى الدنيا الفانية المهلكة ولقيا ما لقيا، ولقي أولادهما ما لقوا من ذلك اليوم إلى أبد الآبدين. ثم دقق في قصة قابيل وهابيل، حيث كان السبب في أمرهما الحسد والشح، وأمعن النظر في قصة هاروت وماروت، حيث كان السبب في شأنهما الشهوة، ثم هلم جرا إلى يوم القيامة.
وبذلك فلن تجد في الخلق فتنة ولا فضيحة ولا ضلالا ولا معصية إلا وأصلها النفس وهواها، وإلا كان الخلق في سلامة وخير، وإذا كان عدو بهذا الضرر كله فحق للعاقل أن يهتم بأمره كما اهتم بذلك الصالحون من الناس.
وإن هذه النفس الأمارة بالسوء إذا جاهدها صاحبها وخالفها في شهواتها حتى أذعنت لاتباع الحق وسكنت تحت الأمر التكليفي، فإنها لا تزال تغلب صاحبها في أكثر أحوالها لتوقعه في الزلل، ثم ترجع إليه باللوم على ما وقع منه، فتسمى لوامة حينئذ، وهي الثانية، وهي مأخوذة من قوله تعالى: » ولا أقسم بالنفس اللوامة « ، فإذا أخذ في محاسبتها ومجاهدتها واستنارت، بحيث ألهمت فجورها وتقواها سميت ملهمة، وهي الثالثة، وهي مأخوذة من قوله تعالى: » فألهمها فجورها وتقواها »، وعلامتها أن يعرف صاحبها دسائسها الخفية الدقيقة من الرياء والعجب وغير ذلك، فإذا لزم المحاسبة والمجاهدة حتى زالت عنها الشهوات وتبدلت الصفات المذمومة بالمحمودة، وتخلقت بأخلاق الله تعالى الجمالية من الرأفة والرحمة واللطف والكرم والود، سميت مطمئنة وهي الرابعة، وهذه وما بعدها إلى السابعة مأخوذة من قوله تعالى: » يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ».
وهذا المقام هو مبدأ الوصول إلى القلب المنور بالأنس بالله تعالى، ولكن مع ذلك ينبغي الاحتراز من مختلف الدسائس الخفية للنفس كالشرك الخفي وحب الرياسة والغرور وغيرها من الأمراض القلبية، فلربما ظن الواصل إلى هذه الإشراقات بأنه أصبح عالما متعبدا وربما ادعى درجة أو مقاما، وهذه من جملة الدسائس، فإذا أدركته العناية الإلهية، ولازم المحاسبة والمجاهدة حتى تمكن من الصفات المحمودة وانقطع عنه عرق الرياء، وصارت نفسه ذليلة، واستوى عندها المدح والذم، ورضي بكل ما يقع في الكون من غير اعتراض أصلا، سميت راضية، وهي الخامسة، ولكن رؤية المرء نفسه بأنه تمكن من الإخلاص لله تعالى ربما أوقعه في شيء من الإعجاب، فيرجع به القهقرى، فليستعذ من ذلك مع مداومة الذكر والالتجاء إلى الله تعالى، حتى يتخلص من رؤية الإخلاص ويدوم على المراقبة والذكر، ولذا سميت مرضية، وهي السادسة، إلا أن صاحب الهمة العلية لا يرضى بالوقوف عند هذه المقامات، بل يجعل شعاره قوله تعالى: » إنما نحن فتنة فلا تكفر » وقوله تعالى: « وأن إلى ربك المنتهى »، فإذا صار إلى منازل الأبطال، وخلف الدنيا وراء ظهره، ناداه ربه بأحسن مقال: «يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلى جنتي »، فيدخله ربه في عباد الإحسان.
وبالوصول إلى هذا المقام قد تمت المحاسبة والمجاهدة والمكابدة، ومع ذلك فلا تأمن لنفسك، بل دائما ينبغي تعهدها وتربيتها، قال السيد بكري رحمه الله: « النفس حية تسعى ولو بلغت مراتبها السبعة »، وذلك تمام المحاسبة والمجاهدة، لأن صفات الكمال صارت لها طبعا وسجية، وتسمى النفس فيه بالكاملة، وهي السابعة، وهي أعظم النفوس قدرا وأكملها فخرا، ومع ذلك لا ينقطع ترقيها أبدا، فلم تزل تترقى حتى تشهد الحق تعالى قبل الأكوان، وهذا عين اليقين، بعد أن حازت علم اليقين الذي هو معرفته تعالى بالبراهين، ثم حق اليقين؛ وهي مشاهدته في كل شيء من غير حلول ولا اتحاد ولا اتصال ولا انفصال، كالمرآة ترى فيها وجهك من غير حلول الوجه فيها ولا اتحاد؛ وهذا مشهد ذوقي لا يدركه إلا أهله.
وصاحب هذه الدرجة لا يفتر عن العبادة؛ لأنها صارت طبعه، إما باللسان وإما بالجنان وإما بالأركان؛ فحركاته حسنات، وأنفاسه عبادات؛ فهو محفوظ من الوقوع في المخالفات لحضوره دائما مع الله في جميع الحالات كما حقق ذلك العلامة سيدي أحمد الدردير والعلامة سيدي أحمد بن محمد الصاوي رحمهم الله تعالى.
وتجدر الإشارة إلى بعض العلماء نبهوا إلى نوع آخر من النفوس، وهو النفس الغافلة غير الجادة، وصاحبها لا يكون عاصيا ولا طائعا، فلا يرتكب المعاصي فيندم، ولا يشعر بحب العودة إلى الله تعالى فيسلم، صاحب هذا النوع يعيش بلا هدف ولا غاية، لم يذق طعم الطمأنينة مرة، فإن أطاع أصحابه فإنه يكون معهم، وإن أساؤوا كان معهم.
ولكي يفهم معنى أنواع هذه الأنفس بشكل أدق، أقول بتعبير آخر أدق، إن الإنسان يمكن أن يمر في حياته بتذبذب عجيب، ففي بعض الفترات تكون نفسه مطمئنة باكية من خشية الله، وفي فترات أخرى تكون لوامة بعد معصية، وفي فترات تكون غافلة، وأحيانا يمر بعض الناس في اليوم الواحد في الحالات السبعة للنفس، فحين يستيقظ صباحا تكون نفسه مطمئنة، وحين ينزل إلى الشارع تكون نفسه أمارة بالسوء، وفي الليل تكون نفسه لوامة، فإذا دخل غرفته يعود من أصحاب النفس الأمارة بالسوء، ويبقى متذبذبا بين هذه الحالات.
بعد هذا البيان لأنواع الأنفس، أريد أن تسأل نفسك بصدق، أي واحدة من هذه الأنفس أنت؟ لتسطيع الانطلاق انطلاقة صحيحة نحو ربك، وتأخذ الاحتياط الكامل من هذه النفس، فإنها أضر الأعداء كما مر، وبلاؤها أصعب البلاء، وعلاجها أعسر الأشياء، وداؤها أعضل الداء، ودواؤها أشكل الدواء، وإنما يلزم عليك الحذر إلى هذه الدرجة القصوى، لأن النفس عدو من داخل، ولا كذلك الشيطان فإنه عدو من خارج، قال سهل بن عبد الله: » ما عبد الله بشيء مثل مخالفة النفس والهوى، فهي رأس العبادة وأول مراتب السعادة، واللص إذا كان من داخل البيت قلت الحيلة فيه وعظم الضرر »، وصدق من قال:
نفسي إلى ما ضرني داعي ۞۞ تكثر أسقامي وأوجاعي
كيف احتيالي من عدو ۞۞ إذا كان عدوي بين أضلاعي؟
وقال آخر:
توق نفسك لا تأمن غوائلها * فالنفس أخبث من سبعين شيطانا وهنا لابد أن أبين إشكالا قد يستشكله البعض، وهو كيف لي أن أعرف بأن الوسوسة من الشيطان أو من النفس؟ أقول في الجواب: الشيطان يوسوس للمعصية بداية، فإن جاهدته أو رفضته تركك مباشرة وذهب ليحدثك بمعصية أخرى، لأنه لا يريد أن يوقعك في معصية بذاتها، وإنما ربحه أن تقع في كل أشكال المعصية، وأي معصية استجبت لها يعد رابحا، أما النفس فإنها مختلفة عن ذلك، هي تبقى دائما تلح على معصية بعينها، فإذا وجدت أن نفسك تلح عليك فلا تظن بأنه الشيطان، إنها النفس، لأنها تشتاق إلى لون معين وتلح عليه، فبداية وسوس به الشيطان، ففعلته مرة، فتلقفته النفس وأعجبها فعندئذ تقوم بالإلحاح والإصرار، ولذلك فإن مرجع اعتياد المعصية إلى النفس التي اعتادت على المعصية لدرجة أن الشيطان لم يعد يزين هذه المعصية، وبدليل أن بعض الذين اعتادوا على معصية معينة أصبحوا لا يجدون لذة للمعصية أثناء ارتكابها، وهم لا يقترفونها إلا من باب الاعتياد، فأنفس هؤلاء تتألم لو تركوا المعصية، وهم لا يرغبون في إتعاب أنفسهم، وهذا كله له سبب وحيد وهو ترك المحاسبة والمجاهدة، ومثل ذلك مثل الأب الذي يبذل جهدا لمنع ابنه عن التعلق بشيء يضره، فلا يلبث أن يستقيم.
ولكي نفرق أكثر بين هواجس النفس ووسوسة الشيطان الرجيم، يكفي أن نتأمل في شهر رمضان مثلا، ففي رمضان وكما ورد في الحديث الصحيح وكما هو معلوم تصفد الشياطين، فما منشأ المعاصي التي تجتاح بعض الناس في شهر رمضان؟ أقول في الجواب: إن منشأها بكل بساطة أنفسنا الخبيثة، أنفسنا الضعيفة التي لم نحاسبها ولم نجاهدها لنفطمها عن المعاصي، والتي أصبحنا لا نرد لها طلبا، أسيرين لديها، تتحكم فينا كما تحب.
فتفكر في حال نفسك هل مازلت عبدا لديها ولدى هواك وشهواتك فيتحقق فيك قول الله تعالى: » أفرأيت من اتخذ إلهه هواه » ؟، واعلموا أخيرا أنه لا يمكن أن نحاسب أنفسنا ونجاهدها ويتركنا الله تعالى لوحدنا، قال تعالى على لسان نبيه الكريم في الحديث القدسي الصحيح: » … وإن تقرب إلي شبرًا؛ تقربت منه ذراعًا، وإن تقرب مني ذراعًا؛ تقربت منه باعًا، وإن أتاني يمشي؛ أتيته هرولة… » الحديث، والحمد لله رب العالمين.
الدعاء الصالح لمولانا أمير المؤمنين ولسائر المسلمين.