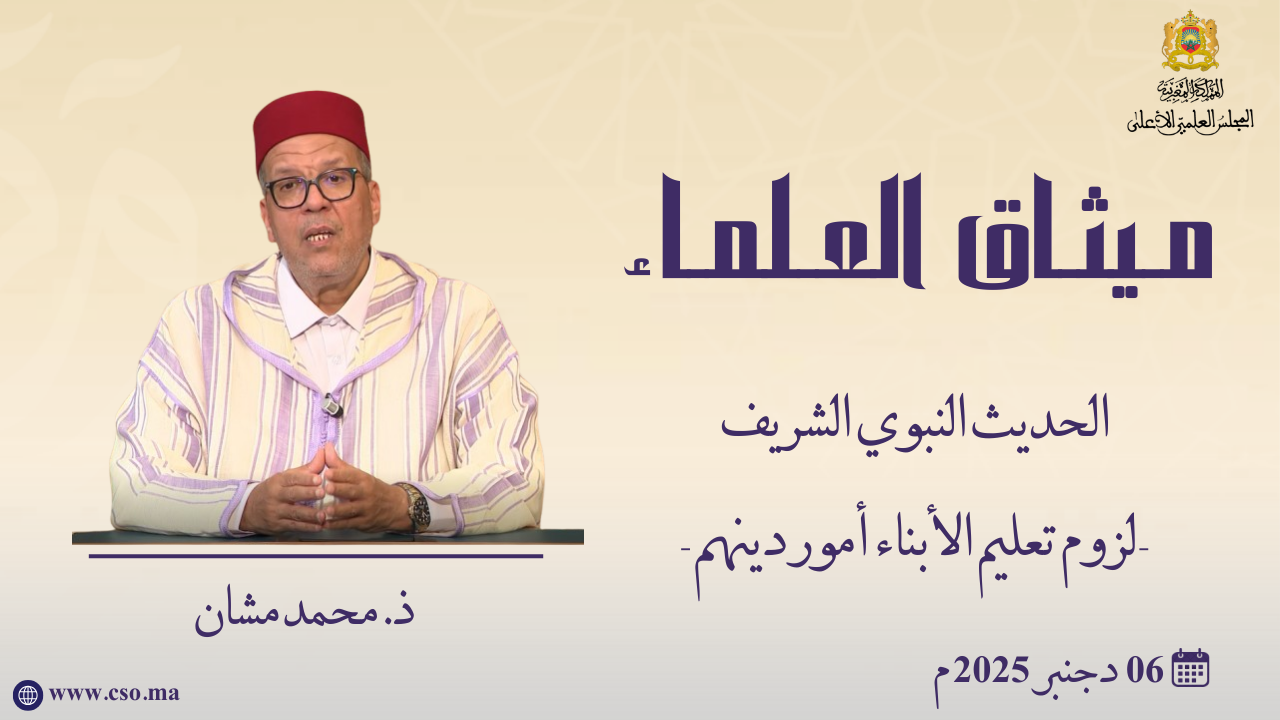النسخة المكتوبة
بسم الله الرحمن الرحيم، وصل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.
السادة الأئمة الكرام؛
المعروف عن أئمة المغرب منذ كانوا أوفياء للحق صادقين في طلب العلم يدفعون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، يمحصون ويوثقون ويدققون هم والعلماء معهم يؤطرون الحياة الدينية، وهو نموذج مغربي يتحقق فيه العمل الجماعي بقيادة إمامته العظمى ويعتبر فيه التأطير بالمؤسسات توجها تسانده من جهة الدين قدسية الأمر الجامع.
انطلقت من هذه الصفة (صفة الصدق) في هذا المجال ابتداء لأعود إليها انتهاء ففي حديث أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ أَتَاهُ جِبْرِيلُ ﷺ وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ، فَأَخَذَهُ فَصَرَعَهُ فَشَقَّ عَنْ قَلْبِهِ، فَاسْتَخْرَجَ الْقَلْبَ، فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ عَلَقَةً، فَقَالَ: هَذَا حَظُّ الشَّيْطَانِ مِنْكَ، ثُمَّ غَسَلَهُ فِي طَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ لَأَمَهُ، ثُمَّ أَعَادَهُ فِي مَكَانِهِ، وَجَاءَ الْغِلْمَانُ يَسْعَوْنَ إِلَى أُمِّهِ – يَعْنِي: ظِئْرَهُ –، فَقَالُوا: إِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ قُتِلَ، فَاسْتَقْبَلُوهُ وَهُوَ مُنْتَقَعُ اللَّوْنِ. قَالَ أَنَسٌ: وَقَدْ كُنْتُ أَرَى أَثَرَ ذَلِكَ الْمِخْيَطِ فِي صَدْرِهِ[1].
استُخرج حظ الشيطان من قلب سيدنا محمد ﷺ فأزال بذلك أصل الأهواء التي تمنع من وصول هدايات رب العالمين، وطهَّره من الدنس الذي قد يحجبه عن الوصول إلى الخير أيا كان نوعه ورتبته، وطهّره لما يؤهله ليكون قلبه وعاءً للوحي وقد وكل الله أمر غسل هذا الوعاء إلى سيدنا جبريل -الروح الأمين- الذي هو أفضل الملائكة وأقواهم، الأمين الذي اؤتمن من رب العالمين كما ائتمنه على الوحي ائتمنه على وعاء الوحي (قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم)، فطهر جبريل عليه السلام محل نزول الهدايات الإلاهية، وكان تطهيره في غايه الإتقان وعلى قدر التكليف، ليؤثر غسل باطن النبي ﷺ على باطنه وظاهره، ومنه تعلمت الإنسانية أن غسل القلوب من الأمراض الباطنية يؤثر في السلوكات الظاهرية، وأن من غسل قلبه من الهوى والشبهات وملأه بالذكر والآيات ظهرت آثار ذلك في المعاملات والعبادات وكل الحركات.
فما هو أول تمظهر لهذه التنقية في حياة رسول الله ﷺ قبل البعثة؟
إن الإجابة عن هذا السؤال هو ما أشار إليه رسول الله ﷺ في قوله للناس يوم أن جهر بدعوته لهم: أَرَأَيْتَكُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلًا بِالْوَادِي تُرِيدُ أَنْ تُغِيرَ عَلَيْكُمْ أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ، قَالُوا: نَعَمْ، مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ إِلَّا صِدْقًا، قَالَ: فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ: تَبًّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ، أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا، فَنَزَلَتْ: ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ﴾[2].
كان رسول الله ﷺ يعيش بين ظهرانيهم يرونه كل لحظة ويلحظون صدقه في المعاملة قبل أن يلحظوا صدقه في الحديث لم يقولوا له رأيناك صادقا وسمعنا عنك صادقا ولاحظناك صادقا، بل جربناك صادقا، لأن مدعي الصدق قد يكون صادقا وقد لا يكون، ولكن من جربه الناس ووجوده صادقا علموا تمكن هذه القيمة منه.
هذا مقام عال في الصدق.
ويُبوب الإمام السيوطي في كتابه الخصائص ” باب خصوصيته ﷺ بتعظيم قومه له في شبابه وتحكيمهم إياه والتماسهم دعاه وتسميته بالأمين”.
عن داود بن الحصين قال قالوا شب رسول الله ﷺ أفضل قومه مروءة وأحسنهم خلقا وأكرمهم مخالطة وأحسنهم جوارا وأعظمهم حلما وأمانة وأصدقهم حديثا وأبعدهم من الفحش والأذى ما رؤي مماريا ولا ملاحيا احدا حتى سماه قومه الأمين[3].
وينقل القرطبي عند تفسير قوله تعالى {وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِۦ وَقَلْبِهِۦ} [الجاثية: 22]، أنها نزلت في أبي جهل حين تحدث الوليد بن المغيرة في شأن النبي ﷺ فقال: “أبو جهل والله إني لأعلم إنه لصادق! فقال له مه! وما دلك على ذلك!؟ قال: يا أبا عبد شمس، كنا نسميه في صباه الصادق الأمين، فلما تم عقله وكمل رشده، نسميه الكذاب الخائن!! والله إني لأعلم إنه لصادق! قال: فما يمنعك أن تصدقه وتؤمن به؟ قال: تتحدث عني بنات قريش أني قد اتبعت يتيم أبي طالب من أجل كسرة[4].
ورغم أنهم شهدوا لرسول ﷺ بالصدق إلا أنه لم يكن يبدوا لهم الصدق كما كان يبدوا لرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يؤثر فيهم كما أثر فيه صلى الله عليه وسلم، لأن النبي الكريم تعرض لحادثة شق الصدر، فصدقه باطني ظاهر راجع للحدث العظيم والاصطفاء الكريم وتحققه بالصدق أصله توحيد وشهادة وحال، وليس فكرا سطحيا كما حصل معهم.
وبه يمكن القول إن تصديقهم لرسول الله ﷺ قبل أن يوحى إليه هو تصديق قبلي برسالته لكنهم لم يستطيعوا الإفصاح عنه، ويستمر هذا الصدق فيهم بعد أن أوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أوله في محفل دولي إذ يشهد أبو سفيان أمام هرقل ملك الروم بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
“جاء في حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود : أن عبد الله بن عباس أخبره: أن أبا سفيان بن حرب أخبره: أن هرقل سأله فقال: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل يغدر؟ قلت: لا. ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال: ولم تمكني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه سجال”[5].
لقد نفى أبو سفيان عن رسول الله ﷺ الكذب وأكد له بهذا النفي أنه صادق مصدوق.
وننبه على شهادة النضر بن الحارث لما خاطب سادة قريش “قد كان محمد فيكم غلاما حدثا أرضاكم فيكم وأصدقكم حديثا وأعظمهم أمانة حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيب، وجاءكم بما جاءكم به قلتم: ساحر!! لا والله ما هو بساحر”.[6]
لقد كان رسول الله ﷺ صادقا في وضع جاهلي مركب، صادقا وسط أفعال وممارسات جاهلية معقدة، صادقا وسط عقول استولى عليها الشرك والأهواء والأنانية والبغي والظلم وبقي صادقا عليه الصلاة والسلام.
وينتقل معه وصف الصدق ويتبدل بتغير مقامات النبي الكريم فسماه قومه بداية الصادق، وسمته الرسالة مصدقا، ثم يكون صديقا ثم يفيض هذا الصدق على صاحبه بعد الاسراء والمعراج.
عن عائشة قالت: لما أسري برسول الله ﷺ إلى المسجد الأقصى أصبح يحدث الناس بذلك، فارتد ناس ممن كانوا آمنوا به وصدقوه، وسعوا بذلك إلي أبي بكر فقالوا: هل لك في صاحبك؟ يزعم أنه أسري به الليلة إلي بيت المقدس، فقال: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم، قال: لئن كان قال ذلك لقد صدق، قالوا: فتصدقه أنه ذهب الليلة إلي بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ قال: نعم، إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك؛ أصدقه في خبر السماء في غدوة أو روحة، فلذلك سمى أبو بكر: الصديق[7]. فصدق أبو بكر خبر النبي الكريم، فدل ذلك أن كرامة الصدق وفضيلته التي تمكنت من رسول الله ﷺ امتدت لصاحبه وأيقن قلبه بها.
وينتقل الصدق لأمنا عائشة الصديقة بنت الصديق، روى البخاري أن رسول الله ﷺ سئل أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. فقلت من الرجال؟ فقال: أبوها قلت: ثم من؟ قال: عمر بن الخطاب. فعد رجالا.[8]
قال ابن حجر: “هي الصديقة بنت الصديق وكان مولدها في الإسلام قبل الهجرة بثمان سنين أو نحوها ومات النبي ولها نحو ثمانية عشر عاما وقد حفظت عنه شيئا كثيرا وعاشت بعده قريبا من خمسين سنة فأكثر الناس الأخذ عنها ونقلوا عنها من الأحكام والآداب شيئا كثيرا حتى قيل إن ربع الأحكام الشرعية منقول عنها رضي الله عنها.” كانت صادقة في محبته صادقة في الإيمان به، صادقة في تعليم الناس.
إن فضائل الإمامة لا تتحقق ولا تتحصل إلا لمن كان صادقا فيها والصدق يقتضي العلم والعمل والناس يتبعون علم الإمام ببصائرهم ويتبعون عمله بأبصارهم.
قال الإمام الشاطبي رحمه الله: إن العالم إذا أخبر عن إيجاب عبادة ما ثم فعلها ولم يخل بها، نهض للعمل بها كل من سمعه يخبر عنها ورآه يفعلها، وإذا أخبر عن تحريم فعل ما ثم تركه فلم يُر فاعلا له ولا دائرا حواليه؛ قوي عند متبعه ما أخبر به عنه، بخلاف ما إذا أخبر عن إيجابه ثم قعد عن فعله، أو أخبر عن تحريمه ثم فعله؛ فإن نفوس الأتباع لا تطمئن إلى ذلك القول منه طمأنينتها إذا ائتمر وانتهى[9]. وما أشار إليه الإمام الشاطبي هو مطابقة صدق الأقوال لصدق الأفعال.
إن الصدق الذي كشف عنه المشركون في رسول الله قبل البعثة واستمر معهم حتى لقي الله هو من علامات النبوة، والأئمة من ورثة الأنبياء في وجوب الصدق في تبليغ الدين ونشره وهم ورثة النبوة من جهة الإنصات للعلماء وتوقير العلم، وهما في الحقيقة أمران لازمان وهذا لا يكون إلا مع تحقق الأفضلية وفاقد الأفضلية لا شرعية له لانقطاع وصله مع النبوة.
خاصة وأن المجتمع ينتظر منه التوجيه بالدين والحال أننا عاهدنا الله على الصدق، فهل انتقلنا به إلى معاملة الناس؟ فيلزمهم ذلك العهد الصدقَ في التعلم والصدق في التزكية والصدق في التبليغ والصدق في إصلاح الحال والجماعة والمحيط، قال ابن القيم: “هذا من أعظم المناقب لأهل العلم، فإن الأنبياء خير خلق الله، فورثتهم خير الخلق بعدهم”[10].
ولما كان كل موروث ينتقل ميراثه إلى ورثته، إذ هم الذين يقومون مقامه من بعده، ولم يكن بعد الرسل من يقوم مقامهم في تبليغ ما أرسلوا به إلا العلماء و”الأئمة معهم”، كانوا أحق الناس بميراثهم، وفي هذا تنبيه على أنهم أقرب الناس إليهم فإن الميراث إنما يكون لأقرب الناس إلى الموروث.”[11]
وبه يكون ميراث الصدق في الإمامة التزاما وسلوكا وقولا وفعلا ووعدا وتطابقا بين ذلك كله.
فمن صدق الإمام: يقينه في نفسه وأهليته لحمل الأمانة التي طوق الله نفسه بها.
ومن صدقه: ألا يعيش ظاهره التضخم في القول على حساب العمل.
ومن صدقه: صيانته جماعته من كل مزاحم ومن كل فكر مضلل وممارسات منحرفة.
ومن صدقه: صيانته المسجد الذي يعمل به، ودفع المنازعة فيه وضبط العمل فيه في أفق تنميته وصيانته ودفع كل صور الإفساد فيه.
ومن صدقه: خدمته للمجتمع بطريقته الخاصة مبشرا بالقيم الجامعة النافعة.
ومن صدقه أن ينخرط في مشاريع المؤسسة العلمية الرحبة اقتداء برسول الله ﷺ الذي كان أنفع الناس للناس.
قال الحق سبحانه: {لِّيَسْـَٔلَ اَ۬لصَّٰدِقِينَ عَن صِدْقِهِمْۖ وَأَعَدَّ لِلْكٰ۪فِرِينَ عَذَاباً اَلِيماٗۖ} [الأحزاب: 8].
فيسأل الله الصادقين من المبلغين عن تبليغ ما أمروا بتبليغه.
ويسأل الصادقين في أقوالهم عن صدقهم في أفعالهم وأحوالهم.
ويسأل الصاديقين في ظاهرهم عن صدقهم في باطنهم.
ويسأل الصادقين في النيات والأقوال عن أثر ذلك في العمل الصالح.
وخلاصة الأمر أن الصدق له متعلقات خمسة: صدق في أمانة الدين وصدق في أمانة الشريعة وصدق في أمانة التبليغ وصدق في أمانة الأسوة وصدق في أمانة الشهادة على الناس، قال الحق سبحانه: {وَإِذَ اَخَذَ اَ۬للَّهُ مِيثَٰقَ اَ۬لنَّبِيٓـِٕۧنَ لَمَآ ءَاتَيْنَٰكُم مِّن كِتَٰبٖ وَحِكْمَةٖ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولٞ مُّصَدِّقٞ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُومِنُنَّ بِهِۦ وَلَتَنصُرُنَّهُۥۖ} [ءال عمران: 80].
بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، وفي حديث وسيرة سيد المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
[1] صحيح مسلم، رقم الحديث: 162.
[2] صحيح البخاري، رقم الحديث : 4770.
[3] الخصائص الكبرى، السيوطي، ج1، ص153.
[4] الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ج16، ص170.
[5] صحيح البخاري: ج1، ص8.
[6] الشفا، القاضي عياض، ج1 ص271.
[7] تفسير ابن كثير، ج 8 ص، 428.
[8] البخاري، رقم الحديث: 3462.
[9] الموافقات، الشاطبي، ج4، ص85.
[10] مفتاح درا السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، ابن القيم، ج1 ص 178.
[11] سبيل العلماء، ص32.