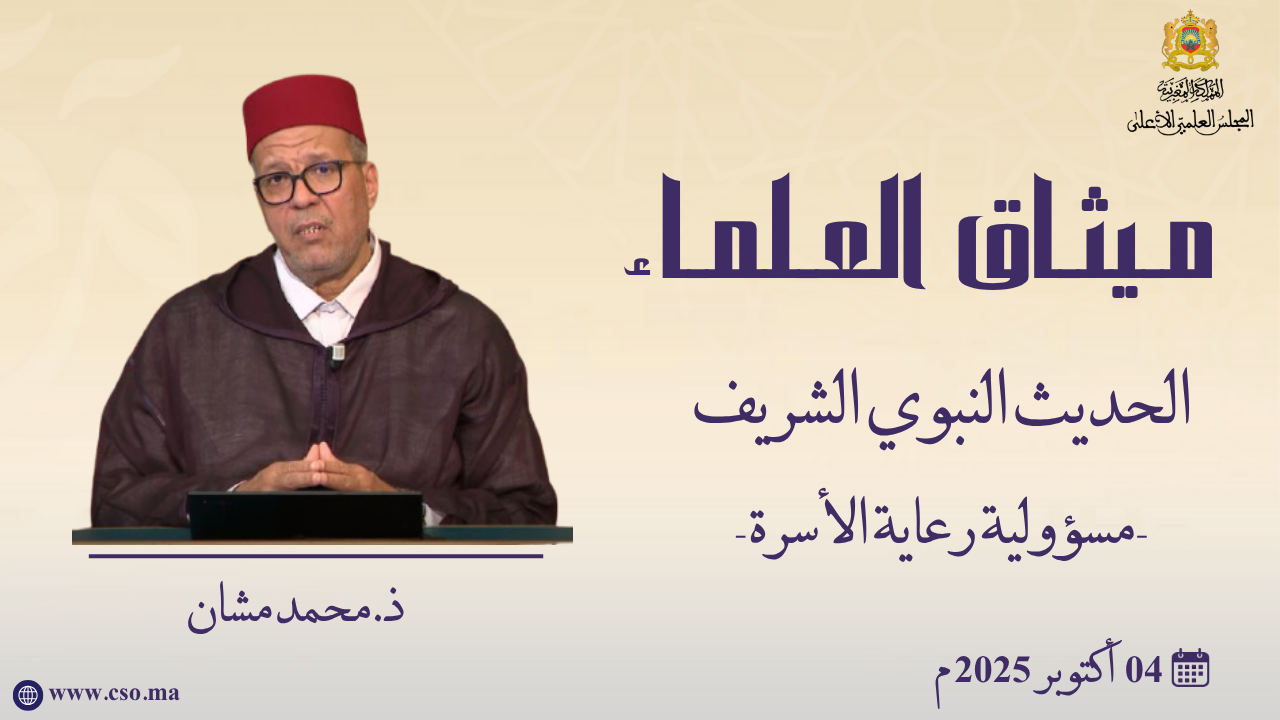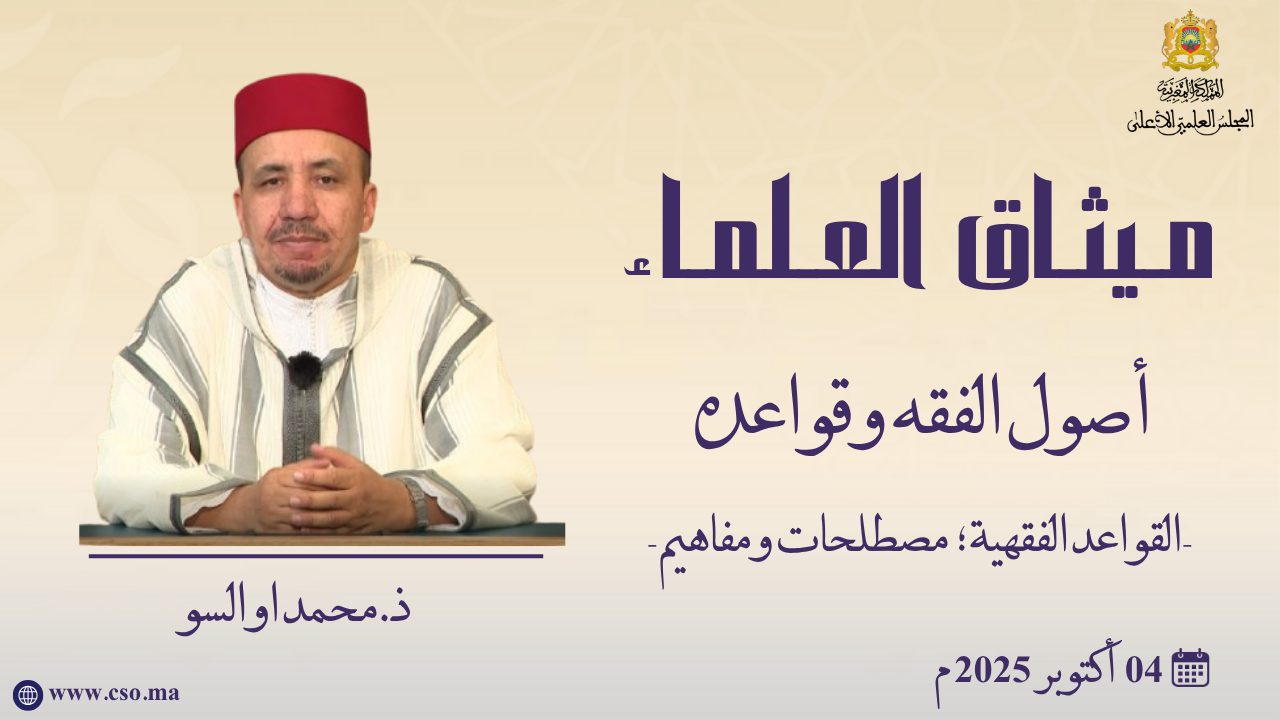النسخة المكتوبة
إن من أهم المحطات الرئيسة في السيرة النبوية، محطة مشهد غزوة أحد التي كان لها تأثير كبير وانعكاس شديد على المسلمين وقتئذ، ذلك أن قريشا لم تنس ما تكبدته من خسائر فادحة في غزوة بدر، وظلت تتحين الفرص للانتقام والانقضاض على الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، ومن أجل ذلك بات أبو سفيان يحرض قومه على قتال المسلمين ويؤلب القبائل على الخروج معهم وتوفير المال والعتاد.
قال ابن هشام: لما أصيب يوم بدر من كفار قريش أصحاب القليب، ورجع فلهم إلى مكة، ورجع أبو سفيان بن حرب بعيره، مشى عبد الله بن أبي ربيعة، وعكرمة بن أبي جهل، وصفوان بن أمية، في رجال من قريش، ممن أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم يوم بدر، فكلموا أبا سفيان بن حرب ومن كانت له في تلك العير من قريش تجارة فقالوا: يا معشر قريش إن محمدا قد وتركم، وقتل خياركم فأعينونا بهذا المال على حربه، فلعلنا ندرك منه ثأرنا بمن أصاب منا، ففعلوا[1].
وبعدما علم النبي صلى الله عليه وسلم بنية قريش، وما رآه في منامه مما أصاب سيفه، استشار صحابته الكرام ليتقرر الخروج لصد العدوان ومواجهة البغاة.
إن في وقائع غزوة أحد وأحداثها مستفادات كثيرات، نقتصر في هذه الحصة على إيراد مستفادين اثنين، وهما: شؤم المعصية، وخطورة الإشاعة.
المستفاد الأول: شؤم المعصية.
إن مما يستوقف قارئ السيرة النبوية، تحول نصر المسلمين إلى هزيمة، بسبب مخالفة الرماة المتحصنين على رأس الجبل لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم القاضي بعدم التحرك من مكانهم مهما كانت نتيجة الحرب، ظنا منهم أن النصر قد حسم، واستعجالهم الحصول على الغنائم التي تشوفت إليها نفوسهم، مما أوقعهم في حرج شديد، وألحق بهم أذى كبيرا بمن فيهم المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي أصيبت رباعيته، وشج في وجهه.
إن هذه المخالفة التي وقع فيها الرماة، وإن لم تكن مقصودة، تجلي خطورة المعصية عموما وآثارها الوخيمة على الفرد والجماعة، وقد ذكر القرآن الكريم ذلك في قوله تعالى: {وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اُ۬للَّهُ وَعْدَهُۥٓ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِۦۖ حَتَّىٰٓ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَٰزَعْتُمْ فِے اِ۬لَامْرِ وَعَصَيْتُم مِّنۢ بَعْدِ مَآ أَر۪يٰكُم مَّا تُحِبُّونَۖ مِنكُم مَّنْ يُّرِيدُ اُ۬لدُّنْي۪ا وَمِنكُم مَّنْ يُّرِيدُ اُ۬لَاخِرَةَۖ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْۖ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْۖ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى اَ۬لْمُومِنِينَۖ} [آل عمران: 152].
قال الحافظ ابن حجر: “قال العلماء: وكان في قصة أحُد وما أصيب به المسلمون فيها من الفوائد والحكم الربانية أشياء عظيمة، منها: تعريف المسلمين سوء عاقبة المعصية وشؤم ارتكاب النهي، لما وقع من ترك الرماة موقفهم الذي أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يبرحوا منه”[2].
إن المعصية سبب كل سوء وشر، فهي مانع من موانع حفظ النعم والآلاء، وسبب في الوقوع في الانحراف والهلاك، وحصول النقم والمحن. ومن أجل ذلك حضنا الشرع الحنيف على تجنبها لما فيها من آثار وخيمة على الفرد والجماعة.
قال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُومِنٖ وَلَا مُومِنَةٍ اِذَا قَضَى اَ۬للَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْراً اَن تَكُونَ لَهُمُ اُ۬لْخِيَرَةُ مِنَ اَمْرِهِمْۖ وَمَنْ يَّعْصِ اِ۬للَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَد ضَّلَّ ضَلَٰلاٗ مُّبِيناٗۖ } [الأحزاب: 36].
وجاء في حديث السفينة أن المعاصي إذا صارت ظاهرة، ولم يكن من الأمة من ينصح بالانتهاء عنها واجتنابها، هلك الجميع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها، وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا، فلو تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا“[3].
المستفاد الثاني: خطورة الإشاعة.
إن من أخطر ما يهدد الجسم الإسلامي، ويفت في عضده، آفة الإشاعة التي إن تفشت وظهرت، فتحت الباب أمام سيول من الأمراض الاجتماعية كالبهتان، والغيبة، وسوء الظن، وغياب الثقة… مما ينجم عنه الهوان والضعف، ومن ثم ذهاب ريح الأمة.
ولأن خطورة الإشاعة أعظم، فقد استندت قريش في غزوة أحد إلى اختلاق إشاعة بوصفها خدعة حربية تروم من خلالها التأثير على معنويات الصف الإسلامي، حيث أذاعوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قتل، مما أوقع بعض الصحابة في ارتباك شديد كاد أن يحسم الحرب لصالح العدو.
ومن أجل تمنيع الأمة من الإشاعة ومن آثارها الوخيمة، نهج الإسلام نهج التثبت من الأخبار وتحري المرويات للتمييز بين صحيحها وسقيمها، ومعرفة أحوال رواتها وصفاتهم.
قال تعالى: {يَٰٓأَيُّهَا اَ۬لذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُۢ بِنَبَإٖ فَتَبَيَّنُوٓاْ أَن تُصِيبُواْ قَوْماَۢ بِجَهَٰلَةٖ فَتُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَٰدِمِينَۖ} [الفتح: 6].
وجاء في الحديث الشريف: “كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع“[4].
قال المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير:” لأنه يسمع الصدق والكذب فإذا حدث بكل ما سمع كذب لا محالة فالتحدث بكل مسموع مفسدة للصدق ومزراة”[5].
ولذلك تميزت الأمة الإسلامية بمنهج صارم في تقويم الأخبار وتمحيصها، ودراسة رواتها وصفاتهم للتمييز بين من تقبل رواياتهم ومن ترد، بما عرف من علومها النقلية بعلم الحديث، وهو علم تميز به المسلمون عن غيرهم من الأمم والشعوب.
إن الحياة الطيبة التي وعد بها رب العزة عباده المؤمنين لا يمكن أن تكون إلا إذا سادت الثقة والأمان، ووقع القطع مع الكذب والبهتان والإشاعة وغيرها من أنواع الظلم والأذى التي تصيب مبدأ الأخوة في مقاتله، وتفتح الباب أمام صنوف الشرور المؤذية.
ومن أجل ذلك عرف النبي الكريم صلى الله عليه وسلم المسلم والمؤمن والمهاجر تعريفات وظيفية بما يجسد السعادة والطمأنينة بالنأي عما يسئ ويضر، ويؤذي ويؤلم، حيث قال عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم: “المؤمن من أمنه الناس، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر السوء، والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بوائقه“[6].
إنها توجيهات نبوية للأمن الاجتماعي الذي يجعل الصدور سليمة، والصفوف مرصوصة، والجبهة موحدة، تجسيدا للإخوة الإسلامية التي تعد ميسما رئيسا للمجتمع الإسلامي، كما قال ربنا عز وجل بصيغة الحصر: {إِنَّمَا اَ۬لْمُومِنُونَ إِخْوَةٞ} [الحجرات: 10]، وهو أهم وصف من أوصاف الحياة الطيبة التي وعد بها الله تعالى عباده المؤمنين.
ويتعين على الأئمة، وهم يؤدون مهامهم التبليغية؛ أن يبصروا الناس بخطورة المعصية والإشاعة، وأنهما خصلتان مذهبتان للسعادة المطلوبة، جالبتان للشقاوة المذمومة، وما يتبع ذلك من فتن واضطراب وتدابر ونزاع…
أقول ما تسمعون، والحمد لله رب العالمين.
[1] سيرة ابن هشام 2/60.
[2] فتح الباري 7/ 347 دار المعرفة – بيروت 1379ه.
[3] أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الشركة، باب شركة اليتيم وأهل الميراث.
[4] سنن أبي داود، باب التشديد في الكذب، وصحيح ابن حبان، وغيرهما.
[5] التيسير بشرح الجامع الصغير 2/ 207 ، مكتبة الإمام الشافعي – الرياض، الطبعة الثالثة 1408هـ – 1988م .
[6] مسند أحمد، مسند أنس بن مالك رضي الله عنه.